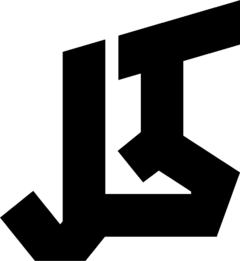وثيقة:الأبوية الطبية: تجارب القابلات القانونيات في لبنان نموذجا
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | هبة عباني |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مجلة كُحل لأبحاث الجسد والجندر |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://kohljournal.press/ar/node/184
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | http://archive.is/UBOHN
|
هذه الوثيقة هي مقالة من العدد الثاني من المجلد الخامس لمجلة كحل
تعدّ القبالة من أقدم المهن في التاريخ، وقد ارتبطت بشكل وثيق وعضوي بالنساء اللواتي زاولنها وكأنهن فُطرن على التمرس بأساليبها ومهاراتها عبر توارث المعارف والخبرات المتراكمة والمتناقلة من أمهاتهن وجداتهن منذ مئات السنين وحتى يومنا هذا. وهنّ تسمّين قابلة وجمعها قابلات أو داية وجمعها دايات، وما من مفردة في اللغة للمذكر. وفي حين كانت القابلات صمّام أمان ودعم بالنسبة للنساء الحوامل والمجتمعات التي كنّ جزءًا منها، حيث كنّ يقدّمن أنفسهن كرفيقات للمشورة وسند يعمل ضمن مجتمعات يؤازر أفرادها فيها بعضهم البعض، إلّا أن النظام الأبوي والرأسمالي الذي أقصى النساء كليًا عن القطاع الطبي استطاع أن يسلب القابلة مكانتها الاجتماعية وحيّزها في المجال الصحّي، وخاصة في مجال صحّة الأمومة، بعد أن أقصى النساء المداويات والشافيات قبل ذلك عن ممارسة الطب عبر العنف والترهيب والتشهير. والنتيجة كانت سلبًا منظّمًا لعلاقة الرعاية والدعم التي حظيت بها النساء الحوامل، واستبدالها بالاختصاص الطبي عامة، وخصوصًا ما يعرف اليوم بطبّ التوليد، ليحلّ الرجل/الطبيب مكان المرأة/القابلة قائمًا ومشرفًا ومقرّرًا في أكثر مواضع المرأة حميمية ودقّة: الحمل والولادة.
دفعني الالتزام بإنصاف القابلات إلى اعتماد منهجية تعتمد بشكل أساسي على مقابلات معهن، ليكنّ المصدر الأساسي لهذه الورقة. وقد قمت بإجراء خمس مقابلات مع خمس قابلات من مناطق مختلفة وفي أطر مختلفة، إثنتين تعملان في مستشفى، واحدة في عيادتها الخاصة، واحدة تعلّم في الجامعة اليسوعية وهي النقيبة المؤسسة لنقابة القابلات القانونيات، والأخيرة تعمل في النقابة، ولكن جميعهن عملن في المستشفى في مرحلة ما. ولكن، بالإضافة إلى العمل الميداني، اعتمدت على مراجعة الأدبيات والدراسات حول تاريخ الطب والنساء والقبالة القانونية، بالإضافة إلى إحصائيات وبيانات مرتبطة بالصحة الإنجابية وصحّة الأمهات والمؤشرات العالمية. وقد اعتمدت في الغالب على أدبيّات ودراسات أجنبية لوضع البحث في سياق تاريخي وسياسي يفسّر مسارات وتطورعمل النساء في المجال الصحي وكيفية تبلور مفاهيمنا ورؤيتنا للصحة وللنساء وانتقالها نتيجة الاستعمار. أمّا بالنسبة للسياق اللبناني، واجهت صعوبة في العثور على نصوص وفيرة تؤرّخ لعمل القابلات القانونيات وتقدّم صورة مكتملة وواضحة عن انتقال النساء من العمل في التوليد من دايات إلى قابلات، وثمّ قابلات مساعدات لأطباء التوليد، فاستندت إلى المقابلات التي تمّ إجراؤها وبضعة موارد تقدّم لمحات حول تاريخ نشوء الطب وتطوّره في لبنان، ووروايات وأحاديث شفهية مع نساء.
تبدأ الورقة بالإضاءة على السياق التاريخي العالمي والمحلّي اللبناني لإبراز التشوّهات في الخطاب الحالي الذي يلفّ عمل النساء في القطاع الصحّي. فهذا الكشف التاريخي بمثابة جسر أعبر من خلاله وعبر محطاته إلى محطتنا المعاصرة، ولكنّي أعود إليه في أقسام أخرى من الورقة لأنه وثيق الارتباط بنتائجه الحالية. ثم، أنتقل إلى النظر في الوضع الحالي للقابلات القانونيات من النواحي القانونية والعملية، لأبحث فيما بعد في الثغرات والعيوب التي يتّصف بها النموذج الطبي المعني بصحّة الأمومة والتوليد، والمتمثّل بأطباء التوليد، كما أقوم بمقارنة هذا النموذج مع ذلك الذي قد توفرّه القابلات، استنادًا إلى شهاداتهن، مقارنة بين هذين النموذجين في بلاد أخرى وفقًا لدراسات ومراجعات.
الخلفية التاريخية
لم يبرح ذلك الألم مكانه حين كنت في السابعة من عمري، حتىّ جاءت جدّتي بزيت ساخن رائحته فوّاحة، ومسّدت في آن برفق وحزم معدتي. جدّتي لم تكن تميّز بين حرف وآخر ولم تعرف ما هي المدرسة قبل دخولي إليها وغيابي عنها لساعات خلال النهار. لكنّها، ورثت عن أمّها ما تيسّر من معارف وهبتها إيّاها الأرض، وخاصّة تلك الوعرة بين الوديان، حيث تنبت الكنوز. هذه المعارف المرتبطة بالشفاء طبعت النساء مئات الأعوام قبل جدّتي، فهنّ كنّ الأكثر ارتباطًا بالطبيعة أي الأرض وأكثر تقديرًا لخيراتها.
وقد قامت النساء، قبل ظهور العلوم الحديثة، باستنباط معارف وعلوم من الطبيعة المحيطة بهن والبعيدة عنهن أيضًا، ودأبن على استكشاف ترياقات وعلاجات أثبتت جدواها وما زال جزء منها مستخدمًا حتى يومنا هذا:
فالمرأة الحكيمة، أو الساحرة كان لديها مجموعة من العلاجات استخدمت على مدى سنوات عديدة. ولا تزال كثير من العلاجات العشبية التي طورتها السحرة مستخدمة في الصيدلة الحديثة. كان لديهم مسكنات للألم وعقاقير مسهّلة للهضم ومواد مضادة للالتهابات. (اهرينريش، 1973، ص. 14)
فإذن، كانت النساء سبّاقات وطليعيّات في ممارسة الطب والمداواة، رغم أنهن لم يملكن الموارد المالية وحرية الحركة والتنقل والأموال لتطوير هذه الممارسة. وعلى العكس من ذلك، عوقبت النساء على نشاطهن في العلاج والشفاء. وقد شهدت أوروبا ما يُعرف بصيد الساحرات، أي النساء ولا سيّما المداويات منهن من خلال حملات منظمة من قبل الكنيسة والدولة، امتّدت من القرن الرابع عشر حتّى القرن السابع عشر، وبلغت ذروة جنونها في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر، حيث تمّ تنفيذ الآلاف من عمليّات الإعدام. قدّر أحد الكتاب عدد عمليات الإعدام بمتوسط 600 حالة سنويًا في مدن ألمانية معينة – أو اثنتين في اليوم. تمّ تدمير 900 ساحرة في عام واحد في منطقة ويرتزبرغ، و1000 في كومو وجوارها. أمّا في تولوز، تمّ إعدام 400 شخص في يوم واحد. في أسقفية ترير، وقدّر العديد من الكتاب العدد الإجمالي للقتلى بالملايين (اهرينريش، 1973، ص. 7ـ8). أمّا في أميركا، تمّ إقصاء المداويات بطرق أخرى، أهمّها التوجه نحو التخصّص والتشويه التدريجي والمنع القانوني للممارسات الخارجة عن الإطار التخصصي الباهظ الكلفة والذي كان مغلقًا أمام النساء.
ونتيجة لتلك الممارسات الوحشية والإقصائية التي طالت النساء المداويات، والتي تزامنت مع حملات من التشهير وتشويه السمعة والوصف بأوصاف شيطانية، حرمت النساء من المضي قدمًا بتطوير الطب وفقًا لرؤيتهن التي انبثقت من مصادر الطبيعة وتوجّهت إلى خدمة مجتمعاتهن المحلية ضمن ممارسة للطبّ والعلاج من منطلقات انسانية وليس كممارسة خاضعة لمعايير السوق والعرض والطلب والربح وتجميع رأس المال. فوفقًا للمرجع الرائع "الساحرات والقابلات والممرضات: تاريخ النساء المداويات"، والذي يخبرنا عن تاريخ النساء في المجال الصحي "غالبًا ما كانت الساحرات المداويات بالسحرة الوحيدات الممارسات للطب في خدمة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الوصول إلى أطباء ولا مستشفيات والمنكوبون فقرًا ومرضًا" (اهرينريش، 1973، ص. 7ـ8). وكنتيجة لتلك الحرب الشرسة، باتت المداويات ممرّضات ومساعدات للأطباء الرجال الحائزين على الشهادات الجامعية والقابضين الحصريّين على منابع العلوم والحقائق العلمية المتمثلة بالمؤسسة الطبية الحديثة. ولم يتمّ استنباط هذه الحقائق العلمية حول الطب الحديث بناءً على تفوّقه في تقديم العلاجات وتحسين صحّة الناس، بل كان ذلك نتيجة لبطش السياسة والمال بوجهما العنيف في أوروبا والمرتبط بضخّ رؤوس الأموال والإقصاء بالقوانين في الولايات المتحدة. فالحقائق التي نعرفها عن اسهامات النساء المداويات في المجال الصحي وتأثيرها على صحّة الناس والمجتمعات تكاد تغيب بينما تحضر إخفاقاتهن فقط، في مقابل مؤسسات طبية ضخمة وهائلة التمويل والموارد البشرية والسياسية، والتي لايبدو أنها تؤدي ضرورتها لناحية تحسين الصحة، فهي إمّا غير متاحة وإمّا متجّهة في مسار ذي كلفة عالية جدًا ونتائج لا زالت لا تمثّل الآمال التي عقدت على الطب الحديث. وفي هذا الصدد يمكننا الاطلاع على تقرير منظمة الصحة العالمية لمراقبة الصحّة للعام 2018، والذي يبرز نتائج مخيفة على أكثر من مستوى، حيث يشير التقرير إلى أنه ووفقًا لإحصائيات العام 2015، ماتت 303000 امرأة لأسباب تتعلّق بالأمومة، وأكثر هذه الحالات كانت في البلدان المتدنية والمتوسطة الدخل. كما يظهر التقرير نفسه ووفقًا لإحصائيات العام 2017 أن هناك 151 مليون طفل تحت سنّ الخامسة يعانون من التقزّم، و51 مليون طفل أقلّ من الخامسة يعانون من نقص في الوزن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب المعرّضون لخطر النونبات لقلبية، كما أن 41 حالة وفاة من أصل 57 مليون وفاة أي 71% من الوفيات هي نتيجة للأمراض غير المعدية (منظمة الصحة العالمية، 2018). ولكن، رغمًا عن هذا الإخفاقات في تأمين الحاجات الصحية للناس الأخطاء الطبية الواسعة الانتشار لا تزال تحظى قانونيًا وسياسياً واجتماعيًا بإجماع شبه كلّي يؤكّد (وإن اشتكى لفظيًا) من خلال ممارسته اليومية واعتمادها مقصدًا للحاجة الصحية أهليتها ومصداقيتها ومرجعيّها في كافة المسائل المتعلقة بالصحة. أمّا القابلات فقد منعن من مزاولة مهنتهن لفترات طويلة، كما لحقت بهنّ حملات تشويه السمعة والاستخفاف إلى أن أصبح دورهن الريادي في مسألة صحّة الأمومة دورًا لاحقًا يشبه ذلك المنوط بالممرضة، ويغدو بدوره دورًا مساعدًا للرجل طبيب التوليد الحائز حصرًا على الثقة والأهلية والأفضلية لرعاية النساء في لحظاتهن الأكثر حميمية.
وفي لبنان، وليد الاستعمار والملتحق حتى النخاع بالنظم والمناهج الأوروبية وآخر صيحات الليبرالية والسوق، يترك هذا التاريخ القمعي والدموي بصمة تبدو ملامحها واضحة إذا ما نظرنا إلى واقع النساء والقابلات في يومنا هذا. وبالفعل، مع وصول الأطباء الأميركيين واليسوعيين إلى لبنان بدأت تتغير معالم مشهدها الطبي، فبدأت شروط ممارسة الطب تتبلور من خلال البدء بوصف الممارسين القدامى بالمشعوذين باعتماد والقوانين. فإن التعليم العالي دخل إلى لبنان أولّا عبر المبشرين الإنجلييين الأميركيين الذين كانوا شديدي الارتباط بالأوروبيين عبر تأسيس الجامعة الأميركية في بيروت والتي عرفت آنذاك كما أنّ تطوّر المسار التاريخي والقانوني والاجتماعي في مجال الصحة يكاد يتماهى مع النموذجين الأميركي والأوروبي من خلال المأسسة التدريجية لهذا القطاع والممارسات القمعية حيال ممارسي/ات الطب "غير المتخصصين/ات". وبالفعل، بدأت معالم المشهد الطبي في لبنان تتغيّر مع وصول الأطباء الأجانب إلى لبنان، الذين قاموا بدورهم بإدخال مفاهيم تضع معاييرًا وشروطًا للممارسات الطبية. فوفقًا لسمير قصير، تاريخ بيروت "حتى منتصف القرن التاسع عشر، كان الطب في بيروت يمارس بطريقة ارتجالية.. لكن الأمور أخذت تنحو منحى مختلفًا مع الإصلاحات المصرية ونمو التجارة في أوروبا. وفي عام 1839 أشار بلو نديل إلى وجود صيدلية يتولّى إدارتها صيدلي متخصّص، موضحًا أن حوانيت العطارين الأخرى لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة" (قصير، 2006، ص. 243). وبهذه الطريقة، أصبح لمفهوم التخصّص الطبي أرضية قانونية ومن ثمّ اجتماعية وثقافية تضع الطبيب في مكانة مرموقة جدًا حيث "بات الناس ينظرون إليه وكأنه نصف إله" (قصير، 2006، ص. 244).
هذه النزعة التخصصية أو العلمية تطوّرت بفعل انتشار المدارس ونشوء أول جامعتين في لبنان: الكلية الإنجلية السورية (الجامعة الأميركية اليوم)، وجامعة القديس يوسف. وفي جميع الأحوال، كان للمبشرّين الأميركيين والفرنسيين الدور الحاسم في إدخال التعليم العالي إلى لبنان، فوفقًا لمسعود ضاهر كانت "مدارس جبل لبنان في القرن التاسع عشر جميعها في أيدي الرهبان والمبشرين.. وكان المبشرون الأميركيون أول من أدخل النشاط الطبي في العمل التربوي في سوريا ولبنان" (ضاهر، 1974، ص. 219). وبحسب المصدر ذاته كانت الجامعتان في تنافس مستمر إذ مثلتا مصالح الاستعمار في الشرق، وقد أدّى ذلك، فيما بعد إلى خنق الجامعة العربية في دمشق، وإلحاقها بهيئة تعليمية أغلبها من الفرنسيين. (ضاهر، 1974، ص. 229-232). وبالتأكيد وعلى نحو مشابه للسياق العالمي، لم يكن التعليم العالي، وخاصة الطب متاحًا للعامة، بل حكرًا على الطبقات الميسورة، فالنجاح المهني الطبي يستلزم متابعة التخصص في دولة أوروبية من أجل ضمان ثقة الناس، حيث يشير سمير قصير في كتابه تاريخ بيروت إلى أن "إعلانات الأطباء في بيروت كانت تبرز نوعية الشهادة المصدق عليها ورقمها، وبطبيعة الحال، الجامعة التي تخرّج منها". وعلى خط مواز لعمليات المأسسة والتبجيل للطب الحديث، تمّ تشويه صورة الطب التقليدي من خلال حملات تصفه بالشعوذة وملاحقات قانونية تقضي بإقفال دكاكين العطارين المخالفة للقانون، وصولًا إلى تعميم التقنيات الطبية الأوروبية بشكل كامل (قصير، 2006، ص. 244-245).
وفي حين أننا لا نعلم الكثير عن أحوال النساء تحديدًا في ظلّ هذه التحوّلات، لكنّ تطوّر القابلات التاريخي الذي يشبه إلى حدّ كبير المسار العالمي حدّد دون شكّ ملامح الدور النسائي في المجال الصحّي والطبي. فقبل أن يكون هناك قابلة قانونية، كنّا نعرفها باسم الداية، في لبنان والمنطقة العربية. وكما في بقية العالم، كانت الدايات تتوارثن المعرفة عن أمهاتهن وجدّاتهن، وترافقن المرأة الحامل خلال حملها وولادتها وكذلك في فترة ما بعد الولادة ومن المؤسف غياب التوثيق للكفاءة التي اتسمت بها تلك الدايات فيما خلا بعض القصص المروية عبر الأجيال، وبعض الشهادات على المواقع الالكترونية. ولكن، من جهة يعتبر هذا أمرًا طبيعيًّا ومتسّقا تمامًا مع نهج الإقصاء ومحو التاريخ وتحريفه لتصبح القصة المتداولة هي عدم كفاءة الدايات وتسببهن بارتفاع حالات وفيّات الأطفال والأمهات بالإضافة إلى التعقيدات التي تتبع الولادة. ومن المعلوم أنّ الدايات مارسن هذه الصنعة لسنوات طويلة وحصلن على ثقة النساء والعائلة برمّتها واستطعن أيضًا تخطّي التعقيدات، رغم معداتهن ومواردهن المتواضعة، حيث تروي الداية أمّ محمد في مقابلة لها مع أحد المواقع الإلكترونية:
وفي إحدى الذكريات الجميلة عندما أنجبت سيدة ثلاثة توائم ذكور شعرت الحاجّة حينها بفرحة عارمة، وتنوه الحاجة سعودي إلى أن أعمار التوائم اليوم فوق الأربعين عاما وما زالوا يرسلون لها السلام مع والدتهم، ومن الحالات أيضا من يزورها ويتفقد أحوالها، وآخرون يهدونها بعض الهدايا تعبيرا عن احترامهم وحبهم لها. (حبيب، 2011)
ومن الواضح أنّ النقمة على الداية لم تكن صادرة عن الناس، وإذا ما سألنا أمهاتنا وخالاتنا عن تجارب أمهاتن مع الدايات لما سمعنا سوى المديح والرضا عن الدايات اللواتي لم تقمن فقط بعمليّات التّوليد، بل كنّ داعمات ومؤازرات ومشجّعات للنساء في بيئاتهن الآمنة والحاضنة وضمن إمكانياتهن وقدراتهن. وفي المقابل، إنّ وصف الداية أو القابلة بالجهل والتخلّف كان نتيجة التحوّل الذي شهدته منطقتنا، وبالتالي لبنان، ظهر مع ظهور الطبّ واختصاصات التوليد. وليس المقصود هنا القول أنّ عمل الدايات والولادات كان يخلو من أي مشاكل وتعقيدات، ولكن من ناحية هناك فرق شاسع في الموارد والمعدّات وسبل الوصول إلى المعلومات بين الدايات والأطباء الممارسين ضمن معايير الطب الحديث، ومن ناحية أخرى هناك محو ممنهج للكفاءة والأثر الاجتماعي في مقابل تضخيم لإشكاليّات رافقت الحمل والولادة وكانت في أحيان كثيرة نتيجة لحروب وأوضاع معيشية وسوء تغذية، إلخ. وأخيرًا، تكثر علامات الاستفهام حول أداء النماذج الطبية الحديثة والمقاربات المتبّعة في صحّة الأمومة ولكن ستعالج الورقة هذه المسألة في قسم لاحق.
وفي هذا الإطار تفيد النقيبة المؤسسة لنقابة القابلات القانونيات في لبنان نايلة دوغان:
الدايات كنّ يقمن بمهام التوليد منذ وقت طويل جدّا. ولكن، اعتبر الأطباء أنّ عمل الدايات يؤدّي إلى مشاكل منها الالتهابات لدى الأطفال وموت الأمهات أو الجنين، فقرّروا خلق مدرسة القبالة. بالإضافة إلى ذلك، كان للداية دور كبير في القرى، حيث يطلبها الجميع، خاصة أن الثقافة كانت تقتضي أن يأتي الطبيب إلى المنزل، فالناس في تلك الأوقات لم يقصدوا المستشفيات من أجل الخدمات الطبية، بل العكس. وفي حين كانت تقوم بكل شيء فيما يخصّ التوليد والطفل وصحّة الأم، ارتأى الأطباء أن يستفيدوا منها بشكل أفضل فخلقوا ما يسمى بالممرّضة ومن ثمّ ما يسمى بالممرّضة-القابلة. (دوغان، 2019)
وبالتالي فقدت الداية مكانتها الاجتماعية والثقة التي اكتسبتها على مدى سنين عمل طوال على الرغم من التحاقها بالجامعات وحيازتها على شهادات، ليتربّع طبيب التوليد (غالبًا رجل) على عرش صحة النساء الإنجابية وتوليدهن. ولم يكن هذا التغيير مجرّد انتقال مهمات من نساء إلى رجال، بل من رؤية إلى رؤية مختلفة تمامًا، من عمل مجتمعي إلى سلعة ممأسسة، من رعاية شاملة إلى رقم في قاعدة معلومات الطبيب. تشرح نايلة دوغان هذا الأمر:
مهنة القبالة بلبنان كانت للداية سابقًا. وكان للداية حينها القدرة على تنصيب مختار أو إزاحته من منصبه... ولكن النظرة الآن تختلف عن نظرة الناس إلى الداية في السابق حيث كانوا يعرفون قيمة عملها والدور الذي تؤديه. وقد عملن في العالم كلّه عندما كانت الولادات تتمّ في البيوت. وقد كان الأطباء يدوّنون ما تقوم به القابلات ويتعلّمون منه، إلى أن اعتبروا أن الدايات يتسبّبن بمشاكل صحية فقاموا بالغاء هذا الدور... تاريخيًا، كانت الولادة عملا جماعيا، يشترك فيه الأهل والجيران وتقوم بإجراءه القابلة في المنزل. أمّا اللواتي لا أهل لهن، فكنّ يقصدن المستشفيات. (دوغان، 2019)
الواقع الراهن للقابلات القانونيات في لبنان
- الأطر القانونية: الأخلاق أولًا؟
يمكن ملاحظة واستشفاف هذا التوجّه نحو تصنيف ووصف الدايات وممارستهن بالجهل وفقدان المهارة، والترويج للمؤسسات العلمية بوصفها مصدرًا وحيدًا للمعارف والخبرات، من خلال ظهور القيود على ممارسة التوليد في لبنان والتي بدأت بفرض شروط ومؤهلّات على النساء اللواتي يمارسن هذه المهنة. وفي حين أن الدايات ربّما كنّ بحاجة لتطوير مهاراتهن وزيادة معارفهن، خاصّة لمواجهة التعقيدات التي قد ترافق الحمل، غير أنّ الأطر التعليمية التي فُرضت شكلّت عاملًا إقصائيًا للنساء، حيث اعتمدت على شكل واحد من نقل الخبرات، أي عبر مدارس القبالة، بالإضافة إلى تمركز هذه المؤسسات التعليمية عند تأسيسها في العاصمة، ممّا يجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للنساء خارج العاصمة. ومن ناحية أخرى، كان تعليم النساء ما زال بالنسبة لغالبية المجتمع أمرًا غير محبذ للنساء أو على الأقلّ غير ضروري، إذ أن "دورها الأساسي" والأوّل رعاية المنزل والأهل أو الأولاد. وبالتالي، أبعدت هذه المركزية لمراكز التعليم والمتزامنة مع فرضها كشرط لمزاولة المهنة عدد كبير من الدايات عن ممارسة هذه الصنعة، جاعلة من ممارسات التوليد خارجات عن القانون، وبالتالي واصمة إياهن قانونيًا ومن ثمّ اجتماعيًا. وبالفعل، لم تتوقّفن عن ممارسة التوليد في القرى والمناطق النائية، ولكن، أنتج هذا التحوّل هرمية بين القابلات، فأصبح هناك من جهة الدايات غير المتعلمّات والممارسات بشكل غير قانوني وغير مهني، والقابلات المتعلمّات والمؤهلات، الأمر الذي وضع حجر الأساس لتغيير الثقافة السائدة والمعتمدة على دايات إلى ثقافة تمنح ثقتها للمؤسسة التعليمية على حساب المعارف المتداولة والشعبية والتي كان يمكن تطويرها ودعمها عبر اعتماد طرائق تعليمية متنوعة ومتاحة حول الأساليب الوقائية وكيفية الحد من المخاطر، تعزّز المهارات الموجودة أصلًا وتستفيد من أسسها وتضمن وصول الدايات إليها، وبالتالي تبقي هذه الخدمة الصحية الخاصة بالأمومة متاحة في المناطق النائية والفقيرة، حيث تعجز هناك النساء وعائلاتهن من الوصول أصلًا إلى الخدمة الطبية بشكلها الحديث. وفي هذا السياق تطلعنا نايلة دوغان على بعض من هذا المسار وتشير إلى أنّه:
تمّ التفكير بإنشاء أولّ مدرسة للقبالة في لبنان في العام 1920، فأصبح مطلوبًا من المؤهّلات لممارسة القبالة أن تكنّ حائزات على شهادة البكالوريا، لتتمكنّ من الالتحاق بالجامعة. فأدّى ذلك إلى إبعاد الكثيرات. كما أن الجامعة كانت في بيروت، وكان ممنوعًا على النساء القدوم من القرى إلى العاصمة، إضافة إلى التكاليف التي لم تكن بمقدروهن. أمًا اللواتي تمكنّ من ذلك فبقي جزء منهن في بيروت، فيما عجزت الأخريات من استرداد تكاليف الدراسة حيث كانت خدماتهن في القرى مجانية نظرًا لطبيعة العلاقات في القرى. (دوغان، 2019)
ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الشروط أكثر صراحة وإلزامية، فبات على الدايات الالتحاق بالجامعات والحصول على إجازات لممارسة القبالة. ومن الملفت، أنّه قبل العام 2003، كان ينبغي على القابلات أن تدرسن التمريض أوّلًا حتى تتمكّن بعد ذلك من متابعة التحصيل العلمي لتصبحن قابلات قانونيات. وهذا الأمر يؤكّد على النظرة العامة للنساء في المجال الصحي الذي يفسح أمامهن المجال باحتلال مكان وحيد: التمريض. وبطبيعة الحال، لم يكن هذا الاختصاص متاحًا من الناحيتين المالية والجغرافية لكثير من النساء، حيث لم توفّره الجامعة اللبنانية في كافة فروعها، ليبقى حكرًا على الجامعات الخاصة، وتحديدًا الجامعة اليسوعية التي كانت سبّاقة في إنشاء مدرسة القبالة في العام 1920، ليتحوّل فيما بعد إلى اختصاص جامعي بعد التمريض، ومن ثمّ اختصاص منفرد في العام 2003. تخبرنا سونيا عثمان، وهي قابلة قانونية من طرابلس عن القيود التعليمية تلك:
في طرابلس، لم يكن هناك فرع لاختصاص القبالة في الجامعة اللبنانية. كان هناك فقط الجامعة اليسوعية. قبل فرض الشهادات الجامعية، كان هناك "معهد دلال الأصيل للتّمريض"، الذي يقوم بتدريس الحياكة وغيرها من الأدوار "المتعلقة بالمرأة"، التي شملت القبالة. قبل ظهور مدارس القبالة والجامعات المتخصّصة، تعرّفت على قابلات من كلّ لبنان، من صيدا وصور لأنهن كنّ يقصدن المعهد هنا في طرابلس، حيث لم يكن بإمكان أي منهن دفع تكاليف الجامعة اليسوعية الغالية جدًا. ورغم ذلك، لم يعد هذا المعهد موجودًا اليوم لأن الدولة قالت أنّه لم يعد قانونيًا أن تدّرس القبالة في معاهد، بل حصرًا في الجامعة. (عثمان، 2019)
وفي العام 1979، أصدرت الحكومة اللبنانية مرسومًا يقضي بتنظيم مهنة القبالة في لبنان (مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، 1979)، ضمّن شروطًا إلزامية لممارسة المهنة، أهمّها حيازة شهادة في القبالة من جامعة أو مدرسة تعترف بها الدولة اللبنانية، إضافة إلى حصولها على شهادة البكالوريا ونجاحها في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي لهذه الغاية. وهكذا اتجهت القبالة نحو التخصص لتصبح مهنة ممأسسة تخضع لمعايير العلم الحديث الوافد إلى لبنان من نوافذ الاستعمار عبر المناهج التعليمية الأوروبية وتحديدًا الفرنسية، والأميركية لاحقًا. ولكن، أكثر ما يثير الاهتمام في هذا المرسوم هو البند الأوّل من لائحة الشروط والذي ينصّ على "أن تتمتع بالصفات الصحية والعقلية والأخلاقية الضرورية لممارسة مهنة القبالة"، والمادة 11 من البنود الجزائية والتي تنصّ على "كل قابلة حكم عليها بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو ثبت أنها مصابة بخلل عقلي أو أنها تدمن تناول المسكرات أو المخدرات لا يحق لها، تحت طائلة العقوبات، ممارسة المهنة، وتسحب منها الإجازة بقرار معلل من وزير الصحة العامة" (مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، 1979).
وبما أن الدولة اللبنانية المنصهرة مع الأبوية لا تخيّب ظنًا يفترض من جانبها تمييزًا واستخفافًا بالنساء، نجد، كما هو متوقّع أنّ الشرط المرتبط بالأخلاق والسلامة العقلية يغيب عن المراسيم الناظمة لعمل الصيدلي أو الطبيب، ليحضر فقط في المراسيم الناظمة لكلّ من مهنة القابلات القانونيات ومهنة التمريض. من السذاجة أن نرى هذا الأمر صدفة لا تستند إلى خلفيّات ومساعي لتكبيل النساء في تلك المهن، وبالنتيجة في المجال الصحي. وإذا ما افترضنا موضوعية وضرورية هذا الشرط، لماذا لا نجده في مراسيم تنظيم مهنتي الصيدلة (مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، 1950) والطب، (أطبّاء بلا حدود، 1979) وهما على تماس مباشر، كما القابلات والممرّضات (مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، 1979) مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية. ولكن، يبرز هذا الشرط أن هناك ربطًا مبطنًا بين الاختلال العقلي والنساء وكأنّ الوضع الطبيعي للنساء هو الجنون والباقي استثناء يجدر إثباته. هذا النهج ليس ابتكارًا للدولة اللبنانية، فالأسطورة الذكورية وصمت النساء بالهستيريا والجنون وممارسة الشعوذة لتنتج نمطًا يتلوّن من عصر إلى آخر ليتماشى مع حداثته. وهكذا يتحوّل حرق الساحرات من قرون بعيدة إلى نصوص منمّقة لا تخدش حياء المنظومة العالمية للحقوق والتحضّر ولكنّها تحمل خبثًا تدسّه في العقول والنفوس وفي الخبز اليومي لتستمرّ بإنتاج خرافتها: النساء ناقصات عقل.
ومن ناحية أخرى، يجدر بالدولة اللبنانية تحديد ماهية الأخلاق قبل فرضها كشرط أوّل لامتهان وممارسة القبالة أو التمريض. فكيف لنا أن نعرف ما هي الصفات الأخلاقية وكيف تقوم الدولة بقياسها والمحاسبة على أساسها؟ هل ممارسة القابلات والممرّضات للجنس عمل غير أخلاقي؟ هل استضافة الرجال في منزلها عمل مناف للأخلاق؟ هل مناقشة الطبيب في المستشفى حول إجراء ما يعدّ قلّة أخلاق؟ هل عودتها إلى المنزل مع زميل لها هو مصدر تشكيك؟ هل يمكنها تناول الكحول؟ هل تعتبر علاقتها بزوجها وأولادها مصدرًا لجدارتها بحسب درجات الطاعة والامتثال؟ وماذا عن الرجال، ألا يحتاجون لبعض من الأخلاق؟
ولكن، هذا ليس بالأمر المستغرب في ظلّ نظام سياسي يستمد هيمنته من قوانين أحواله الشخصية الطائفية التي تنبذ كلّ من يغرّد خارج سرب العائلة الطائفية، أي الوحدة الأكثر أهمية لناحية إعادة إنتاج النظام بحكامه وقوانينه ومؤسساته وأدواته ومفاهيمه وأخلاقه. فالعائلة هي المكوّن الأساسي للمجتمع والبوابة الحصرية للمواطنة والوصول إلى الحقوق. وبالتالي، تصبح أخلاق العائلة من أخلاق الأمة. ولأن شرف العائلة وأخلاقها يرتبط جذريًا بشرف وأخلاق نسائها، يغدو قمع النساء و"تأديبهن" ضربًا من ضروب حفظ شرف العائلة وبالتالي الوطن، ومبرّرًا للاستمرار في التمييز الممنهج ضدّهن وإبقائهن تحت وصاية أنسابهن الذكورحتى لا تفسد أخلاق الأمة. فتتحوّل المرأة من فرد مواطنة ذات حقوق وواجبات إلى امرأة تخضع لوصاية لرجل وتحمل اسم نسبه وتتحمل مسؤولية صون هذا النسب وعدم تلطيخه أو الإساءة إليه داخل العائلة وخارجها. وعليه، يصبح هناك ضرورة لضبط سلوكيات وممارسات المرأة في المجالات العامة حتى لا يتناقض ذلك مع البنى الأخلاقية والهرمية والوظيفية لوحدة العائلة، فيختل النظام برمته. وبالتالي، نجد أصداء المسائلة الأخلاقية للنساء في القوانين المدنية والجزائية أيضًا التي تميّز في عقوباتها بين الزاني والزانية وتعاقب النساء المتزوجات من رجال أجانب بحرمان أولادهن من الجنسية، وتحد من حصولهن على المزايا في عملهن، وتحرمهن من قراراتهن الجنسية والانجابية ومن التحكم بأجسادهن.
بالتأكيد، تختلف رؤيتنا "للأخلاق" التي تحرص عليها الدولة عن صداها الحتمي في ايجابيته والمنزّه عن أي تشكيك، حيث تعمل هذه الكلمة البرّاقة، "الأخلاق" بالمنهجية ذاتها. فمن منّا يملك الجرأة للاعتراض على فرض الأخلاق، ليصبح بالتالي ضدّ/عديمًا للأخلاق. وهكذا، تظهر الدولة اللبنانية قلقة على الشأن العام وحريصة على الحفاظ على الأخلاق والسلامة المجتمعية في مواجهة الانحلال الأخلاقي النسائي الذي يهدّد كياننا الغارق في جنّات يحرسنا ملائكة من الرجال. وفي الوقت ذاته، تصبح النساء القابلات والممرّضات مكسر عصا باستطاعة أي كان تهديدهن بأخلاقهن بعيدًا عن موضوع النزاع، ما يزيد من هشاشتهن في مواجهة أي مظلومية يتعرضن لها، كنزاع على مسألة طبية، منافسة على مكانة ما، تحرّش جنسي، عنف، إلخ.
في المقابل، يحمل هذا المرسوم بعدًا تعتبره القابلات ايجابيًا لجهة تحديده لدوره القابلة القانونية وإعطائها صلاحيات من شأنها أن تمنحها بعضًا من الاستقلالية. وهي تنص على الآتي:
المادة 1- إن القابلة القانونية هي المأذونة بعمل التوليد الطبيعي، تسهر على صحة الحامل مدة الحمل وحين الوضع تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بمهمتها.
المادة 2 - في حال تعسر الولادة، على القابلة القانونية أن تستدعي الطبيب أو أن ترسل الحامل إلى المستشفى.
المادة 3 - يحق للقابلة القانونية العمل بمفردها وفي دور التوليد وفي أقسام التوليد في المستشفيات المختصة بالأمراض النسائية والتوليد وفي المستشفيات والمستوصفات والعيادات المختصة بأمراض الأطفال في حدود نطاق واجباتها المهنية.
المادة 4 - تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الأدوات والأدوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لأجل ممارسة مهنتها. (مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، 1979)
وفي حين تبدو بعض جوانب هذا المرسوم واعدة، لا سيّما في مادته الأولى، فهو يبقي على شكل من أشكال الهرمية بين الطبيب والقابلة في مادته الثانية، كما أنّه لا يحدد ماهية الأدوية التي يحق للقابلة وصفها، فتفيدنا القابلات اللواتي تمّت مقابلتهن أن لائحة هذه الأدوية تتغيّر وتتعدّل وتتمركز نوعية هذه الأدوية على بعض من المضادات الحيوية، ذلك يترك حدود ممارسة القبالة خاضعًا لرحمة قرارات المؤسسات الرسمية الراسخة في بيروقراطيتها وتجاذباتها السياسية وذكوريتها. ومن جهة أخرى، يعكس الواقع الماثل على الأرض وفي المجال التطبيقي صورة مختلفة تمامًا.
- القبالة في الحيّز التطبيقي
تندر اليوم الولادات في البيوت، بعد أن كانت في السابق ممارسة طبيعية ومنتشرة. فبعد أن كانت خيارًا لمعظم العائلات، أصبحت الولادات المنزلية ملاذًا لمن لا يملك تكاليف الولادة في المستشفى. ولا يزال الاعتقاد السائد والناجم عن حملات التشويه في لبنان يفيد أنّ المستشفى تمثّل المكان الأكثر أمنًا وسلامة لإجراء الولادة، علمًا أن الولايات المتحّدة والدول الأوروبية التي ابتكرت مؤسسات الطبّ الحديث باتت تتجّه بشكل واسع إلى العودة إلى الولادات المنزلية، حيث توفّر هذه الأخيرة البيئة الأكثر راحة ودعمًا للنساء في حالات الحمل والولادة:
فالإقبال على بيوت الولادة يزداد عاماً بعد عام، ففي بلدان أوروبا الغربية تتم أكثر من 75 في المئة من الولادات على أيدي قابلات قانونيات...وفي الولايات المتحدة تشير دراسة صادرة عن "الجمعية الوطنية الأميركية" إلى تزايد الإقبال على بيوت التوليد في شكل لافت.. فزاد تبعاً لذلك معدّل الولادات من20 ألفاً عام 1975 إلى 200 ألف عام 1994. (الحياة، 2014)
ومن جهة ثانية، لا تفرض الولادات المنزلية على القابلات تكاليف وأعباء تأسيس العيادة. ولكن، هذا التغيير الجذري وضع القابلات أمام معادلة تضع الاستقلالية المهنية والكفاية الاقتصادية في مواجهة بعضهما البعض. ليغدو الحقّ بالاستقلالية المهنية ترفًا للقادرات على تكبّد مشقاته المالية أو جهدًأ مضنيًا ومضاعفًا تدفع ثمنه النساء مالًا ووقتًا وصبرًا وصمودًا. وبالتالي تبقى هذه الخيارات وحدها متاحة أمام القابلات: المستشفى، العيادة الخاصة، ومؤخّرًا نتيجة الأزمة السورية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحّة ومنظّمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
ومن جديد، يفرض الواقع العملي توجّه القابلات إلى خيارات دون الأخرى. حيث أن الوظائف المتاحة في المراكز الصحية والمنظّمات هي وظائف حديثة النشأة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأزمة السورية، كما أنّها تضعهن ضمن هرمية أخرى على الرغم من الآثار الجيّدة التي تركتها هذه التجربة لناحية قدرات القابلات والاستجابة الهائلة التي قدمنها في ظلّ نظام صحّي لبنان يعتبر الصحّة سلعة لا تحقّ إلا لذوي الدخل المرتفع ليبقى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود خارج نطاق التغطية الصحية. في هذا السياق تفيد القابلة مارجي ميدلتون وهي قابلة قانونية ومسؤولة مشروع يُعنى بالرعاية الصحيّة للأمهات والحوامل في منظّمة أطباء بلا حدود: "ليس لدى العديد من اللاجئين معارف في لبنان، وبالتالي يصعب عليهم العثور على المساعدة داخل المجتمع المحلي". (أطبّاء بلا حدود، 2013) تضيف ميدلتون: "غالباً ما تجهل النساء الحوامل أين يجدر بهن الذهاب. وقد سمعنا قصصاً عن نساء اضطررن للولادة وحيدات دون مساعدة وتحت خيمة. أتأثر كثيراً بمثل هذه القصص لأنني قابلة وأعرف مدى خطورة الأمر ومدى المعاناة والرعب الذي تعيشه أمّ وهي تضع وليدها وحيدة" (أطبّاء بلا حدود، 2013). أمّا إنشاء عيادة خاصة لا يعدّ خيارًا فعليًا، حيث تواجه القابلة التي تريد أن تمارس عملها ضمن عيادتها الخاصة عقبات جمّة أبرزها النظرة الدونية التي تغلب على العقلية اللبنانية وعلى عقلية النساء اللبنانيات، واعتقادهن أن أطباء التوليد أكثر كفاءة. ففي حال، تمكّنت القابلة أوّلًا من دفع أقساط الجامعة، وثمّ توفير المبالغ اللازمة لتأسيس العيادة، يبقى عليها أن تخصّص مبالغ إضافية للصمود في وجه منافسة أطباء التوليد إلى أن تثبت جدارتها من جديد لتكسب نساءً يقصدن عيادتها. وبالفعل، تندر عيادات القابلات القانونيات مقارنة مع عيادات أطباء التوليد، وهي وفقًا لعواضة، قابلة قانونية تمت مقابلتها، تقارب ال30 عيادة في لبنان (عوادة، 2019)، وهو عدد قليل جدا بالنسبة لعدد القابلات القانونيات. أمّا كالين صفير، وهي قابلة قانونية تمّت مقابلتها، فتخبرنا عن تلك التجربة وما تكبّدته من جهود ومصاريف حتى تنعم باستقلاليتها وتمارس القبالة بالطريقة التي تحبّ، حيث كانت قد عملت في المستشفى أكثر من مرّة ولكنها شعرت أنها محدودة وغير قادرة على ممارسة ما تعلّمته. ولكن، هي تدرك أن المنافسة مع أطباء التوليد هي ضرب من ضروب الخيال. فالشهادة التي تملكها لا تخولها على منافستهم نتيجة النظرة الاجتماعية التي ترى في الطبيب محط ثقة. استلزم كالين حتى تدخل في إطار المنافسة أن تصبح أكثر تخصّصًا. وبالفعل، تابعت دراستها في فرنسا وتخصصت اختصاص فرعي في القبالة يسمى obstetrical ecography. وهو اختصاص لم يكن موجودًا في لبنان. ولكنها، تعتبر نفسها محظوظة كونها تمكنت ماديًا واجتماعيًا من السفر للحصول على شهادة أو اختصاص إضافي إذا صح التعبير. كما تضيف أنها عانت كثيرا في البداية، ولكنها أيضًا كانت محظوظة لتتمكن من الصمود حتى بدأ الناس بالاقبال على عيادتها كونها تخصصت في هذا المجال الفرعي للقبالة (صفير، 2019).
ولكن ماذا عن القابلات اللواتي لا تملكن ترف التحصيل العلمي الجامعات الفرنسية ولا الوقت أو الضمانات الاجتماعية التي تمكنهن من ذلك. لماذا ينبغي دائمًا على النساء أينما حللن أن يبذلن مالًأ وجهدً ووقتًا مضاعفًا للوصول، ولماذا عليهن إثبات جدارتهن باستمرار؟
ومن جديد، تؤكّد نايلة دوغان على هذا الواقع، فتقول:
كان على القابلات العاملات في عيادات تكبّد مسؤوليّات ومصاريف جمّة، ففضّلن العمل في مستشفى، ولكنهن خسرن استقلاليتهن وأصبحن في أسفل الهرم الذي بات يتصدره الطبيب. ومع الوقت، استطاعت هذه الهرميّة أن تغيّر نظرة الناس إلى القابلة. (دوغان، 2019)
فإذن تبقى المستشفى الخيار شبه الوحيد المتاح وليس المناسب بالنسبة للقابلات القانونيات، حيث تعمل معظمهن في المستشفيات، باعتبارهن موظّفات يتلقين راتبًا شهريًا. لا يتخطّى هذا الراتب مبلغ الألفي دولار، إلا في حالات قليلة وبعد مرور سنوات عديدة من العمل والخبرات المتراكمة. وقد عبرت عن هذا الأمر القابلات اللواتي تمت مقابلتهن. ويغطّي هذا الراتب إجمالًا 3 إلى 4 أيّام عمل في المستشفى، ضمن دوامات ليلية أو نهارية مدّتها 12 ساعة. ولكن، العمل في مستشفى، بصرف النظر عن محدودية مردوده المالي، يحدّ من مهام القابلة ويحيلها إلى منفّذة لتعليمات طبيب التوليد. إذ أن الطبيب يملك السلطة النهائية في تقرير الإجراءات المتّخذة حيال المرأة الموشكة على الولادة، بينما لا يحقّ للقابلة بالمشاركة في اتخاذ القرار، تعبر كالين صفير عن تجربتها في المستشفى:
عملت في المستشفى أكثر من مرة، ولكني شعرت أني محدودة جدا، حبث لا أستطيع أن أطبّق قناعاتي، قالطبيب دائمًا يفرض قرارته وله الحق الوحيد في القرار. العمل في مستشفى يحدّ من القابلة ويجعلها تؤدي دور الممرضة، بينما أنا أعرف أنه باستطاعتي القيام بالولادة ووصف الأدوية وأحيانًا أعلم أني على حق في حالة ما ولكن أضطر للرضوخ إلى قرارات الطبيب، وبعد فترة اعتدت على تنفيذ الأوامر عندما يأست فقررت أنه لا يمكنني العمل في ظلّ نظام كهذا. (دوغان، 2019)
يحصل هذا الإقصاء مع العلم أنّ القابلة ترافق المرأة منذ لحظة وصولها وتقوم بكافة المهام والرعاية اللازمين للمرأة إلى أن تصبح جاهزة تمامًا للولادة حتى يتولّي الطبيب الأمر من هناك، كما تشرح حنان عواضة بدقّة:
نحن نقوم بكل شيء ونؤدي كافة المهام، نأخذ السيدة إلى غرفة الولادة لكي تراها وتتآلف معها، نشرح لها ما سنقوم به وما هو وضعها ونسألها عن تاريخها الطبي ونتحدث معها ونراقب وضعها ونبقى معها إذا كانت بحاجة إلى إبرة الظهر. وخلال هذه الفترة التي قد تمتد إلى أكثر من 12 ساعة أحيانًا يأتي الطبيب مرة أو مرتين على الأكثر ولمدة 5 دقائق أو 10 دقائق كحدّ أقصى، وعندما تصبح جاهزة للولادة يأتي ويقوم هو بالولادة. (عوادة، 2019)
وبالتالي، تقوم القابلة بكل شيء، باستثناء التوليد، أي مهمتها الأساسية التي مارستها منذ آلاف السنين، ليُترك لها مهمة مساعدة الطبيب والعمل الرعائي، الذي على أهميّته ودوره الأساسي في عملّية الشفاء والذي لا يقلّ أهمية عن التدخلات الطبية عبر الأدوية والإجراءات الأخرى، يعتبر أقلّ قيمة من من الجانبين المادي والمعنوي مقارنة بالشقّ الطبي الصرف، وهو أمر ليس مستغربًا ويرتبط ارتباطًا عضويًا بالتنميط الجندري للنساء، وفي الوقت ذاته في تحديد قيمة متدنية لأعمال النساء، فالنساء مسؤولات عن العمل الرعائي الذي يقمن به مجانًا في المنزل وبأجر زهيد في مجالات العمل، كما أن الأعمال الرعائية "الخاصة بالنساء" هي ذات أجور زهيدة، كما أنّها تحظى بنظرة دونية.
ما نستنتجه وبوضوح أن النظام الأبوي دائم الحرص على نزع الانسانية عن المرأة، فهي بالنسبة إليه ستبقى دائمًا وقبل كل شيء امرأة، أينما وجدت. وبالتالي، رؤية هذا النظام للنساء كأشياء، كمواضيع قابلة للاستغلال والتحرش، كعناصر خاضعة للرجال ومؤتمرة بقرارتهن، كناقصات، كخادمات غير مأجورات في منازل تغطيها الأسرار، ستمتدّ حتمًا إلى أروقة المستشفيات الناشئة أصلًا على مبدأ استبعاد النساء، وسيحاول جاهدة إبقاء المرأة قابعة في أسفل سلم القطاع الصحي بالصرف النظر عن كفاءتها وجهودها، وخاضعة لإرادة الطبيب في جميع الأحوال، وهذا ليس غريبًا عن النساء، أوليس هذا امتدادًا لدورهن "الطبيعي" في المنزل.
وبالفعل تعبّر كالين صفير عن دينامية التعامل الذكوري الذي تشبه إلى حدّ كبير التماهي دينامية التعامل مع الأب أو الزوج، كما هو رب البيت هو رب المستشفى ولديه السلطة الأعلى، وذلك في معرض حديثها عن الطريقة التي كانت تتبعها لإقناع الطبيب بالعدول عن إجراء العملية القيصرية الذي رأته إجراءًا متسرعًا، فهي لا تستطيع أن تبدي رأيها بوضوح، من ندّ إلى ندّ، وعليها دائمًا مراعاة الهرمية، حتى لو كانت محقّة. تقول بعد ابتسامة: "علينا أن نجد طريقة لإقناعه، نكلّمه بهدوء ونقترح بما يشبه التحايل وليس عبر فرض رأينا. مثلًا نقول له، ما رأيك أن تبقى في عيادتك حتى انتهاء الدوام، ثمّ نرى بعد ذلك إن نجحت المرأة وولّدت بطريقة طبيعية" (صفير، 2019). ولا بدّ من التنويه أنّنا لسنا بمعرض التهكّم على الطبيب بوصفه فردًا يتمتع أو لا يتمتع بصفات معينة، ذكورية كانت أم لا، بل بصدد توصيف نظام كامل يضع فئة في موقع متسلط على فئة أخرى ويجعلها بعيدًا عن أي شكل من أشكال المحاسبة عند ارتكاب الأخطاء سواء الطبية منها أو الأخلاقية مع المرضى والنساء الحوامل أو مع الممرضات والقابلات. وهناك قصص كثيرة ترويها نساء ولدن في مستشفيات وترويها ممرضات وقابلات عن نزق الأطباء وطريقة تعاملهن مع النساء سواء كانو مريضات أو ممرّضات أو قابلات، لتبلغ درجات التسامح مع الطبيب حدًا يتيح له التنمّر، إصدار الأوامر، القيام بممارسات طبية غير صحيحة (سنتطرق لذلك في القسم الأخير)، والتحرش، حيث تروي إحدى القابلات م. س.، وهي ترفض ذكر اسمها بالكامل عن تعرضها لتحرش لفظي من طبيب توليد في إحدى المستشفيات. حيث قام هذا الطبيب وعلى سبيل "المزاح" بالتعليق على إحدى القابلات أمام زميلاتها واصفًا إياها في وضعية جنسية معه في الليلة السابقة كسبب لتعبها في ذلك اليوم. وفي حين أنها لم تجد في "مزحته" التي لا تمت إلى الواقع بصلة، سوى تحرشًا جنسيًا غير مقبول من طرفها، طلبت منه الاعتذار عمّا قاله. ولكنه رفض بالتأكيد. فما كان عليها إلا أن أخبرت الإدارة التي رفضت طلبها وحاولت تهدئتها معتبرة أن الطبيب يمزح وأنه من المقبول أن يقوم بتلك المزحات لأنه يقوم بها دائما. "فهذه طريقة كلامه" هكذا قالوا لها (صفير، 2019).
ولكن، هل للطبيب بمفرده القدرة على بسط سلطة كهذه؟ وهل تأتي هذا السلطة فعلًا من مهارة وعلم يفوقان غيره من العاملات في المجال الصحي، أم أن مصدر سلطته يتغذّى ويغذّي بنية النظام الأبوية والرأسمالية التي تقمع وتقصي النساء من جهة، وتجعل من الحقوق الصحيّة سلعة تنافسية عصيّة على الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ هذا ما سنقوم بمعالجته في القسم الأخير من خلال تسليط الضوء على المقاربات والممارسات المختلفة في مجال صحّة الأمهات والصحّة الانجابية، كما الإجراءات والخيارات الطبية التي باتت أمام النساء الحوامل، والبعد الاقتصادي للنظام الصحّي فيما يخصّ صحّة الأمومة والولادة.
صحّة الأمّهات في قبضة طبيب التوليد
أقوم في هذا القسم بالمقارنة بين مقاربة الدايات سابقًا والقابلات حاليًا وتلك الخاصة بأطباء التوليد العاملين ضمن النظام الطبي الحديث، من أجل إبراز الإختلافات والتباينات في النتائج الصحية فيما بين هذين النموذجين عبر النظر في جوانب عدّة منها الكلفة، نوعية الرعاية، طريقة الممارسة، والنتائج المترتبة على صحّة الأمومة بشكل عام. ولا شك أن أبرز هذه الاختلافات يكمن في المنطلقات الأساسية في النظرة إلى الولادة. فالقابلات تقاربن الحمل الولادة بوصفهما فعلًا طبيعيًا، أي أنه يحصل من تلقاء نفسه متتبعًا نظامًا بيولوجيًا مجهزًا بطبيعته لإتمام الحمل وإنجاز الولادة، فتقوم به المرأة وتحدد قوانينه ومواعيد جسدها، وبالتالي يعترفن بجسد المرأة باعتباره جسدًا واعيًا لحاجاته بحكم تركيبته وفطرته الطبيعية، ومؤهلًا للولادة من دون تدخّل طبي بمعنى من دون إجراء طبي إضافي يتمثل بإدخال عناصر كالأدوية والجراحة، فيما خلا الحالات حيث تبرز تعقيدات أو مشاكل صحية معينة. وتعتبر القابلة أنّ التدخّل المطلوب ينبغي أن يلعب دورًا مرافقًا ومواكبًا للمرأة في هذه الفترة الدقيقة والحميمة، وداعمًا لها ولخياراتها. ترى القابلة في الحمل تجربة شديدة التأثير بالمرأة، وهي فعلًا كذلك، وبناء على ذلك تنظر إلى موضوع الحمل بطريقة شاملة وليس فقط من ناحية التفاعلات الجسدية والعضوية، بل ترى أن صحة المرأة والجنين تخضع لعوامل كثيرة تتفاعل مع بعضها البعض لتيّسر مسارًا طبيعيًا، أي الولادة، وتضمن حصوله بأمان وراحة وثقة. في المقابل، ينظر الطبيب إلى الولادة كوضع بحاجة إلى علاج أو على الأقلّ إلى تدخّل طبي ما، فتقتصر مهمّته بشكل حصري على إجراء الفحوصات ووصف الأدوية من دون الأخذ بعين الاعتبار للجوانب الرعائية الأخرى التي تحتاجها النساء في مرحلة الحمل خصوصًا، وكافة الأشخاص المستفيدين/ات من الخدمات الصحية، حيث يسقط مفهوم الرعاية من المقاربة الصحيّة للطبيب بشكل شبه كامل تنعدم أحيانًا فيه المقاربة الانسانية لمسألة الصحّة. تخبرنا سيدة تمت مقابلتها عن تجربتها الصادمة في الولادة والتي أدّت بها إلى أزمة نفسية بعد الولادة عن ما عرضت له في إحدى المستشفيات. تروي أنها لم تتجاوب مع المخدّر وظلّت لفترة معينة قادرة على السمع وخلال ولادتها كانت تسمع صوت الطبيب يقول أنها "متل البقرة وناصحة وكيف بدنا نبرمها" وإلخ من هذه الأمور (م، 2019). وهكذا تصبح الحامل مريضة فتتغيّر احتياجاتها الأساسية إذ تفقد الرعاية والمتابعة وتستبدلهم بزيارات سريعة وملف طبي وبضع أدوية. وفي هذا الإطار تقول نايلة دوغان:
مهمتنا ليست فحسب القيام بالولادة، بل هي مهمة تبدأ منذ لحظات الحمل الأولى. نحن نرافق المرأة في كافة مراحل حملها، وقبله وبعده. فخلال هذه المرافقة هناك بناء ثقة وتبادل وتشارك لمسائل خاصّة وحميمة. إن علاقة المرأة بالقابلة هي علاقة أساسية في حياة المرأة، من شأنها أن تمكّن المرأة وتمنحها القدرة على اختيار الخيارات الأفضل لصحتها. هذا الرابط الحميم انكسر في ظلّ وجود المعادلة الجديدة التي استبدلت هذه العلاقة بعلاقة مع طبيب قد ينسى تفاصيل وضعها لأنها بالنسبة إليه زبونة وعليه أن يرى أكبر عدد من الزبائن في أسرع وقت ممكن. بعض النساء تنتظرن الطبيب على أمل أن يظهر، وهنّ لا تعلمن أنه لن يعود، فتبقين بالانتظار وترفضن أن تقوم القابلة بفحصهن إلى أن تيأسن من رجوع الطبيب فتقبلن في النهاية.. وأيضًا خسرت النساء قدرتهن على تقرير خياراتهن الانجابية، وبتن خاضعات لتعليمات الطبيب التي، في أغلب الأوقات تملي عليهن قراراتهن الانجابية. أمّا القابلة فهي تواكب المرأة ولا تملي عليها قراراتها، لأن تمكين النساء يقع في صلب ضمان صحّة أفضل لها. والعكس صحيح، فصحة النساء هي قرارهن الواعي والمستنير... (دوغان، 2019)
ومن جانب آخر، قدّمت المداويات الساحرات، والدايات حفيداتهن في هذا الجزء من العالم عملهن في خدمة مجتمعاتهن فاستفادت منه الفقيرات وغير القادرات على تكبّد تكاليف الرعاية الصحيّة، ووجدن فيه دورًا اجتماعيًا يمارسنه، حيث تجيب الداية أمّ محمد لدى سؤالها عن أجرها "أعوذ بالله عمري ما طلبت من حدا فرنك (...) كل واحد وجهده". كما تستذكر "إحدى الأسر المستورة" التي أصر الأب فيها أن يعطيها أجرها ولكنها رفضت وقالت بعطف: "يمه اشتري فيهم دجاجة لزوجتك" (حبيب، 2011). أمّا القابلات القانونيات اليوم، فهنّ موظفات يعملن ل 12 ساعة في اليوم مقابل راتب محدّد بصرف النظر عن عدد النساء والولادات والمهام. بينما يرى الطبيب في المرأة الحامل زبونة، فكلّما ازداد عدد الزبونات ازداد الربح وتقلّص الوقت المخصّص للعناية بالمرأة. أمّا في المستشفى، فالطبيب هو متعاقد يتقاضى أجرًا عن كلّ حالة تصل عبره، وكلّما ازداد عدد الحالات كلّما ازداد سلطة على المستشفى وابتعد عن المسائلة والمحاسبة. وكنتيجة لذلك، تنتقل لوثة مضاعفة الربح إلى أروقة المستشفى، فيغدو الطبيب زائرًا سريعًا للنساء، كما أنّه أحيانًا لا ينجح في الوصل لإجراء الولادة، فتقوم القابلة بهذه المهمّة، ولكنّه، مع ذلك، يتقاضى أجره لقاء عملها، وأحيانًا يقبض الطبيب أجرًا "من تحت الطاولة" من المرأة ليقوم هو بتوليدها، بالإضافة إلى ما يتقاضاه من المستشفى وفق ما روت حنان عواضة خلال المقابلة (عوادة، 2019). ولا تقتصر ممارسات الأطباء على مقايضة الوقت اللازم للعناية بالربح المالي، بل أنّها أرست نمطًا من الخيارات الطبية التي تثير القلق من أجل مزيد من الربح المالي لناحية الارتفاع الشديد في نسب الولادات القيصرية، الولادات المبكرة المفتعلة، الطلق الاصطناعي، إبرة الظهر، وغيرها. ومن الملفت أنّ هذا التسليع للخدمة الطبية يجري بالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين. يلخّص الدكتور عدنان مروّة هذه العملية ببراعة ودقّة لا متناهين:
في لبنان، يتبيّن من المسوحات منذ التسعينات المنحى التصاعدي في اعتماد الولادة القيصرية... والنسبة الأعلى كانت في بيروت حيث تتوفّر أعداد وفيرة من المراكز وأطباء التوليد، كما تتوفر سهولة الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة. نسبة الولادة القيصرية كانت متدنية في محافظة لبنان الشمالي، فالأنماط الاجتماعية ما زالت تعتمد على الولادات المنزلية وعلى دور أكبر للقابلات فيها. يزداد اللجوء إلى الولادات القيصرية مع توفر التامين الصحي. هذا التفاوت في اعتماد الولادة القيصرية لا يمكن تفسيره بمبررات علمية أو فوارق فيزيولوجية وانما يعكس إلى حدّ كبير الافراط في التدخلات الطبية... في لبنان قد يرتبط الافراط في اعتماد الولادة القيصرية الى التخمة في أعداد أطباء التوليد... لذا يسعى الى توقيت مواعيد الولادة للحوامل عبر اللجوء الى عقاقير لتحفيز تقلصات الرحم أو ثقب الكيس الأمنيوسي أو الولادة القيصرية. هذه التدخلات من شانها أن تزيد من احتمال تعثر الولادة او الانتهاء بالعملية القيصرية وقد ازدادت ممارسات توقيت موعد الولادة من نسبة متدنية في السبعينات والثمانيات الى نسبة 25 % من الولادات حاليًا، لأسباب مختلفة أهمها الرغبة في تحاشي العمل في أوقات معينة، والفروق بين التعويضات المهنية للعملية القيصرية والولادة الطبيعية. كما أن للمركز الاستشفائي مصلحة في زيادة إشغال الأسرّة وبالتالي المردود من الشركات والصناديق الضامنة. (مروّة، 2010)
وفي المحصلة، نجد أن حاجات الأمهّات الصحية بشقيها الرعائي والطبي أصبحت عرضة للتدهور على الصعيدين النفسي والجسدي نتيجة تفضيل مقاربة الأطباء ومنحها الثقة العمياء في اتخاذ القرارات المرتبطة بصحة الأمومة وتطبيقها على أجساد النساء بدلًا من إشراكهن، وفرض التدخلّات غير المطلوبة وغير الملائمة بهدف زيادة الأرباح وكسب مزيد من الوقت من أجل زيادة الزبائن. فوفقًا للقليل الذي أوردناه لا يبتعد أطباء التوليد في لبنان عن مقاربة الحمل بالولادة مقاربة انسانية فحسب، بل يخرق بواسطة تلك الممارسات توصيات منظمة الصحة العالمية حول ضمان نوعية الخدمات الصحية المرتبطة بصحة الأمومة، وهي: الأمان أي عدم إلحاق الأذى بالمرضى بواسطة العلاجات التي من المفترض أن تداويهم؛ مركزية المرأة وهي تقديم العناية المحترمة والمستجيبة لخيارات وحاجات وقيم المريض/ة وأن تكون كافة الخيارات العيادية مستندة إلى مبادئه/ا؛ الفعالية أي تجنب الهدربما في ذلك هدرالمعدات والمواد والأفكار والطاقة؛ والكفاءة أي تقديم الخدمات بناء على معرفة علمية إلى كل من هو بحاجة إليه.
خلاصة
يمكننا أن نستنج ممّا سبق أنّ الأبوية والرأسمالية توأمان يتحّدان لصنع عالم يجعل من سكانه بؤساء وفاقدين لأبسط حقوقهم في سبيل زيادة الربح. ويبدو واضحًا أنهما يتغذيّان ويكمّلان بعضهما البعض. حيث تعمل الأبوية على الإمعان في قمع المرأة وتعنيفها لتصبح أكثر عرضة للاستغلال، في البيت حيث تعمل بشكل مجاني، وفي سوق العمل الذي يواظب على منحها أجورًا زهيدة مقابل أعمال متعبة وشاقّة. ولا ينفصل القطاع الطبي عن النظام الكلّي في الاعتماد على الأبوية وخطابها وقوانينها ليضع من جديد النساء في قوالب تنعتهن بالجهل وعدم الكفاءة وتقلل من شأنهن، كما تبيح لنفسها ارهابهن عبر انتهاك حواسهن وأجسادهن من خلال التحرش اللفظي والجسدي والتعنيف الكلامي الذي يحط من قدرهن والأساليب الفوقية لتعمل كافة هذه الأدوات في الحدّ من وصولهن إلى حقوقهن وتمتعهن بالتقدّم والاستقلال المهني والشخصي. وبطبيعة الحال، تذهب جائزة الانجازات الأبوية إلى الرأسمالية التي لم تتوافق تمامًا مع اتجاهات ومقاربات النساء في المجال الصحي فأصبحت قيمتها مضاعفة، حيث تعمل النساء في المستشفيات لساعات طويلة مقابل القليل، ويبرع الطبيب في التفنّن بابتكار إجراءات وتدخّلات طبية ترفع من قيمة الفاتورة. كما أنّ التواطئ في هذا النهب المنظّم يجري بمباركة النظام اللبناني الذي يتكبّد صندوق ضمانه الاجتماعي تكاليف كل ولادة يجريها طبيب في مستشفى، في حين أنّ القابلات القانونيات موظّفات ضمن راتب موّحد بصرف النظر عن عدد الولادات، وهنّ اليوم بتن مجازات وأعضاء في نقابة، ومكلّفات بمرسوم حكومي بإجراء الولادات الطبيعية.
وفي حين اعتمد الطب الحديث خلال عملية إقصائه للدايات والقابلات على التعبئة لعدم كفاءة القابلات بحجة ازدياد نسبة وفيّات الأمهات والمواليد الجدد، وانتشار الالتهابات وغيرها من المشاكل الصحية، يبدو الطب الحديث أكثر خطرًا على صحّة الأمومة اليوم في ظلّ المعطيات الحالية، حيث أنّ خفض معدّل وفيّات الأمهات أصبح من أهداف التنمية للألفية، وبات الإجراءات الطبية تشكّل خطرًا متزايدًا على صحّة الأمهات سواء لجهة تزايد العمليات القيصرية أو التحديد المسبق للولادة عبر تزويد المرأة بعقاقير، إلخ. والأهمّ من ذلك، أنّ هذا النظام الطبي الحديث يقصي الأكثر فقرًا وتهميشًا بشكل كلما من الوصل أصلًا إلى الخدمة الصحية. ولعلّ أبرز أوجه التعاون بين الأبوية والرأسمالية تتمثّل في إرساء ثقافة استهلاكية لدى النساء الأمّهات، حيث باتت خياراتهن تعتمد بشكل رئيسي على المظهر النخبوي لعملية الولادة والمتمثّل بموضة اختيار تواريخ ولادة جذّابة، وأطباء مشهورين، والاتجاه نحو العمليات القيصرية لتجنب آلام المخاض أو تجنّب "تشوّه" أعضائهن التناسلية جرّاء الولادة الطبيعية.
والمطلوب اليوم، العمل على فضح هذه المنظومة، وتخصيص مزيد من الموارد والدعم للقابلات بكافة الأشكال المتاحة. فهذه الورقة هي نتاج عمل تطوّعي محدود الموارد، بينما يبقى الكثير من الحقائق المستورة قسرًا برداء الأبوية المقيت، وهناك أصوات تنتظر لتخبر قصتها سواء من ناحية التفاني الذي قدمته الدايات سابقًا والقابلات اليوم، أو من قبل النساء غير المرتاحات في علاقاتهن مع أطباء التوليد. وقد حاولت هذه الورقة الإجابة عن أسئلة كثيرة، ولكنها انتهت بأسئلة أكبر وأعمق تتطلب جهدًا وموردًا والتزامًا بانصاف جداتنا وأسلافنا وطبيعتنا الأم.