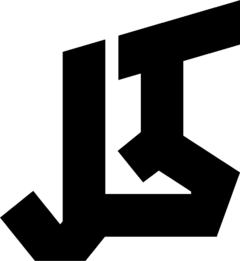وثيقة:هل هو اغتصاب أم فعل مشين؟ العدالة الانتقالية كمقاربة بديلة لتناول العنف الجنسيّ في دوائر المجتمع المدني في مصر
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | هل هو اغتصابٌ، أم "فعلٌ مشين"؟ العدالة الانتقالية كمقاربةٍ بديلةٍ لتناول العنف الجنسيّ في دوائر المجتمع المدني في مصر |
|---|---|
| تأليف | سما التركي |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مجلة كُحل لأبحاث الجسد والجندر |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://kohljournal.press/ar/node/235
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.is/J0QSm
|
نشرت هذه المقالة في المجلد 6، عدد 1 في مجلة كحل.
تقديم
ينبغي أن تُفهَم حوادث العنف الجنسي، كالتحرش والاغتصاب على سبيل المثال، بوصفها كذلك، كي يَتسنّى اتّخاذ ما يَلزَم لمجابهتها. لأجل هذا الغرض، تُحاول المجتمعات، رسمية أو غير رسمية، تطوير نظم مختلفة للاستجابة لهذا النوع من العنف. لكن، ماذا لو لم تتمكّن الإجراءات المتّبعة في تلك النظم من التعرّف على العنف الجنسي، ومن ثمّ اتخاذ ما يلزم لمنعه؟ يحاول هذا البحث طرح العدالة الانتقالية كمقاربةٍ بديلةٍ حيال العنف الجنسي. كذلك فإنه يفتح الباب للنقد الذاتي وتحليل كيف تعاملت كلّ من الحركة النسوية المصرية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات غير المنتظمة مع قضية "فتاة الإيميل" على وجه الخصوص، وقضايا العنف الجنسي إجمالًا. هذا البحث هو وقتٌ مستقطع أو فسحةُ للتأمل في كَنَه وأسباب ما حدث، وكيف تفاعلنا معه كنسويات مصريات. وإن لم يكن بوسعنا التخلص من العنف الجنسي بين عشيةٍ وضحاها، لم يزل بالإمكان النظر بعين النقد لتفاعلاتنا معه أملًا في مستقبل أكثر عدلًا.
ينبثق مفهوم العدالة الانتقالية من اتساق جهود المجتمعات المُهمّشة حول العالم لمجابهة العنف دون السقوط في فخ إعادة إنتاج عنف النظام. ينبع ذلك عن إيمانٍ بدور المجتمعات في التخلّص من العنف على المدى الطويل. لذا قد يكون ذا نفع للمجتمعات التي تعيش في ظل سوء الإدارة أو العنف الجنسي من قبل الدولة، أو حيثما تكون الدولة في خلافٍ سياسي مُستحكِم مع المجتمع المدني، كما هو الحال في مصر. ترتكز العدالة الانتقالية على التغيير السلوكي ومنح الوقت اللازم لتعافي الضحايا عبر توسيع تعريف الضحية/الناجي/ـة ليشمل المجتمع ومرتكب الأذى وأشكال التعسف المتقاطعة كافّة. أطرح هنا العدالة الانتقالية كمقاربةٍ بديلة للعدالة تنبني على جهود المجتمع والمساءلة الجمعية.
ينطلق تحليلي من السياق المصري، لا سيّما من التجارب المجتمعية التي وقعت بين عامي 2017 و2018. وأعني بالـ"مجتمع" مجموع العاملين/ـات والفاعلين/ـات في دوائر المجتمع المدني المصري. كانت الواقعة نفسها خلافيّة إلى حدٍّ كبير، إذ كان ضمن أطرافها المرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي،1 والمحامي الحقوقي ذائع الصيت، محمود بلال. في كانون أول – ديسمبر من العام 2017 أرسلت الضحية / الناجية،2 والتي ظلّت هويتها معمّاةً خلال سير القضية، رسالةً إلكترونية إلى مجموعةٍ من النسويات المصريات تتهم فيها بلال باغتصابها وهي ثملة في منزلها في العام 2014، كما اتهمت علي بمحاولة "مضاجعتها" في مكتبه. مثّلت الواقعة الأخيرة بحسب شهادتها التي وَرَدت في الرسالة الإلكترونية "واحدة من أكثر التجارب تقززًا" في حياتها، ما جعلها تُسائل حياتها الجنسية برمّتها.3 السياق السياسي للواقعة والمواقع المختلفة للنسويات اللاتي استقبلن الرسالة فتحت الباب على سجالٍ واسع بين المجموعات النسوية / اليسارية.
ضمن مظلّة العدالة الانتقالية، أحاول أن أعيد قراءة الواقعة كاملةً وأن أقدّم بيانًا بالدروس المستفادة من تجارب نسوية أخرى تستند إلى العدالة الانتقالية المجتمعية. أطرح كذلك واقعًا مغايرًا تكون فيه المساءلة الجمعية نواةً للقضاء على العنف الجنسي في دوائر المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. لذا سأقارن بين كيفية تعامل المشهد المصري الحالي مع العنف الجنسي وتبعات ذلك، وما يمكن أن يبدو عليه هذا المشهد نفسه إذا ما كانت العدالة الانتقالية مُطبّقة. استناداً إلى أدبيات العدالة الانتقالية وتجارب مشابهة، طوّرت أربعة أسئلة: ما هي المنهجية المستخدمة في تناول العنف الجنسي ومن هم/ـن المنخرطون/ـات في عملية تناوله؟ لمَن يحقّ تعريف الضحية/الناجي/ـة؟ من المتسبّب بالأذى؟ كيف تتدخل المجموعات النسوية؟ تُشكّل هذه الأسئلة مجتمعةً إطارًا لعمل العدالة الانتقالية يشمل التدخّل الإجرائي والتعافي والمساءلة والعدالة. هذه الورقة هي بدايةٌ لمناقشة الدروس التي يمكننا كنسويات مصريات الإفادة منها وتكييفها بما يلائم واقعنا.
ومن الجدير الإشارة إلى أن هذه الورقة ليست بصدد مناقشة الإلغائية، فذلك يتطلّب ما لا يتسع له المقام هنا. ما أحاول طرحه هو نُظُم عدالةٍ بديلةٍ ورديفة كقنوات تختار الضحية/الناجي/ـة من بينها. أتحدّث من موقعي كنسوية مصرية شابة وكعضوة غير فاعلة في حزب "العيش والحرية" وكباحثة مستقلّة. وأعي محدِّدات عملي البحثي: بشكلٍ متعمّد لم ألتمس أي سبيل للتواصل مع الضحيّة / الناجية بغرض البحث، بُغية احترام قرارها بالانسحاب من المشهد والعملية برمّتها. كما لم يكن لدي اطلاع على تفريغ التحقيقات نظرًا لسريّة الملفات، ولم يتسن لي مقابلة المجموعات التي انخرطت ضمن مفاعيل القضية بسبب ضيق الوقت. عوضًا عن ذلك، أحاول من خلال تحليلي هذا أن أطرح تبنّي العدالة الانتقالية في السياق المصري، ضمن مساعينا الجمعية للتغلّب على المشاكل التي ظهرت لدى مجابهة العنف الجنسي بالوسائل غير الرسمية.
ما هي العدالة الانتقالية؟
كمنهجيةٍ لمعالجة العنف من منظورٍ اجتماعي، تُقدّم العدالة الانتقالية الغايات بعيدة الأمد على الحلول الآنيّة. وتُركّز على ضرورة العمل المنتظم والمتسق لتطوير سبل التصدّي للعنف الجنسي من خلال الوقت والتحالفات (العدالة الانتقالية والمساءلة المجتمعية، 2013) خلافًا للمنهجيات العقابيّة التي تعتمد على التقارير الرسمية وتدخل الدولة وتنتهي بالاعتقال، تعمل العدالة الانتقالية عبر مقاربة مجتمعية بحيث يُعزّز أحدهما الآخر (العدالة الانتقالية والمقاربة المجتمعية) (روسو، 2019: 89)، فالعنف ليس حدثاً فردياً وإنما هو فعلٌ نظاميٌ هيكلي يتجذّر في الماضي ويُمارَس في الحاضر. التحوّل من اليومي إلى الهيكلي يسمح لنا بفهم العوامل التي تُمكّن وتُغذّي العنف عبر إعادة إنتاج أنساقه.
من السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات دفعت الحركات النسوية المناهضة للعنف باتجاه تجريم العنف الجنسي الأسري. تزامنت هذه الدفوع مع تزايد الاعتقالات في الولايات المتحدة وتجاهُل الأبعاد الإثنية والجندرية لحوادث العنف. قُوبلت اعتراضات النسويات الملوّنات والسود على نظام العدالة الجنائية بالتجاهل، إذ غَلَب التمثيل الأبيض على المجموعات النسوية المناهضة للعنف (كيم، 2018: 224-225). تاريخ العدالة الانتقالية يضعنا أمام قياسٍ مهم، فممارسة الدولة للعنف والتمييز بشكل ممنهج ضد المواطنين الملوّنين، تعني حكمًا أن صولجان العدالة الاعتقالية، أيًا كان شكلها، سيكون مُسلطًا على رقاب الملوّنين أكثر من أقرانهم البيض. نظرية كرِنشو عن التقاطعية (1991) تُفَصّل الفرق بين تجارب الأفراد استنادًا إلى تقاطع الجندر والعرق والطبقة والفئة الاجتماعية (انظر/ـي كيم، 2018). إذ اتضح أن تجارب الأشخاص الملوّنين كانت دائمًا أكثر قسوةً وعنفًا. تلك التجربة المعاشة هي ما يدفع الحراكات المناهضة للعنف وأطر عمل العدالة الانتقالية، خصوصًا في ظل العنف الممنهج من قبل الدولة ضد الأفراد الملوّنين، الذين يجدون/ـن أنفسهم/ـن خارج أطر المؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح والإفادة من الخدمات العامة (بييرا وآخرون، 2011؛ تشن، دولاني وبيبزنا-سماراسينا، 2011). بالمثل، تُميّز العدالة الاعتقالية ضد الأفراد الملوّنين وتُكرّس لإيديولوجيا التفوّق الأبيض.
برغم غياب مثل هذه المعادلة في السياق المصري، إلا أن القضاء المصري لا يتورّع عن الإجحاف علنًا بالمتقاضين، ويستهدف الفاعلين بالمجتمع المدني على وجه الخصوص (راجع/ـي ملف مصر لدى "منظمة العفو الدولية"). فضلًا عن الاعتقال المباشر، تستخدم الدولة السلطوية العنف الجنسي لتعيير الفاعلين/ـات بالمجتمع المدني في مصر عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة. لذا أجد العدالة الانتقالية كإطارٍ محتملٍ لتقصّي العدالة عوضًا عن نموذج الدولة للعدالة المعتمِد على التحكّم والضبط والعقاب والاعتقال.
عبر توسيع التعريفات، تكسر العدالة الانتقالية ثنائيّة الضحية / الجاني: فالفعل المسيء يتخطّى الفرد ليشمل المجتمع ككلّ بما فيه العائلة ومحيط الأصدقاء. بالمثل فإن مرتكب الفعل لا يقف وحيدًا في موضع المساءلة، بل تلحق به أشكال مختلفة من العسف كعنف الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والسياسات والممارسات الاجتماعية. فلكل منها دورٌ في الحثّ على العنف، والعدالة الانتقالية تأخذ هذه الأدوار كافّة بعين الاعتبار (روسو، 2019: 97-100). تختلف لغة هذه المقاربة عن تلك المعمول بها في السياقات القانونية التقليدية (كالدفاع والادعاء والجريمة). فهي ترى العنف كأذىً اجتماعي تتضافر فيه عوامل اجتماعية وسياسية. لذا، فالـ"ضحية" هو/ـي أيضًا جزءٌ من المجتمع الذي يقع فيه العنف، والـ"جاني" رغم كونه هو من قام بإيقاع الأذى إلا أن المجتمع أيضًا هو من وفّر له شروط وقوعه (روسو، 2019: 102).
العنف الجنسيّ في مصر هو نوعٌ من العنف الهيكليّ ضدّ النساء. هو عنفٌ متجذّرٌ في الوعي الأبويّ والذكوريّ لمجتمع يلغي أي فاعلية لجسد المرأة، فأجساد النساء هي مسؤولية الدولة والمجتمع وذكور العائلة. يتجلّى هذا في دوائر العام والخاص؛ الرسمي وغير الرسمي (في قوانين الدولة وانتهاكات الشرطة ضد النساء وجرائم الاغتصاب والتحرش وفي أماكن العمل وفي ممارسات الختان والاغتصاب تحت مظلة الزواج وفي تعذّر حصول النساء على حقوقهن الجنسية الفردية) (راجع/ـي تقرير "الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان" وتقرير "نظرة"، 2016) كاستجابةٍ هيكلية لطبقات وأبعاد عدّة، تعتمد العدالة الانتقالية على المساءلة والتدخّل الجمعي. جمعيات العدالة الانتقالية كجمعية "كريساليس" و"كرييتف انترفنشن" و"فيلي ستاند أب" و"فيليز بيسد" تعتمد على التخطيط الجمعي وتقاسُم الجهد لتحقيق المساءلة والتعافي.5 لا يقوم عمل هذه الجمعيات على عمليات تَسري من أعلى لأسفل حيث تمتلك جماعةٌ أو فريق بعينه الجواب لإنهاء العنف، بل يتطور الجواب عبر التداول الجماعي ضمن مقاربةٍ تشاركيّةٍ شاملة. يضمن ذلك إشراك الناجي/ـة والمجتمع ككل في صياغة التدخّل بما يخلق بيئة تتحوّل فيها المسؤولية والمساءلة الجمعية إلى "موارد داخلية لإدراك وتدارك الأذى الذي تسبّبنا فيه لأنفسنا وللآخرين" (بورك، 2011). على المدى الطويل، تتمكّن المجتمعات من توطيد آلية مستدامة للتصدّي للعنف الجنسي عبر إعادة ممارسة المساءلة الجمعية، "بحيث يستمر أثر العدالة الانتقالية وبحيث يـ/تشعر المشاركون/ـات بالنشاط لا بالاستنزاف عند الاضطلاع بإجراءات التدخّل أو المنع تلك" (جنرايشن فايف، 2019). في أغلب الحالات، الناس مستعدون للتدخل لوقف العنف، إلا أنهم في أغلب الحالات أيضاً يجهلون كيفية فعل ذلك، وهنا يأتي دور العدالة الانتقالية (روسو، 2019: 133).
تُوفّر العدالة الانتقالية المكان والزمان اللازمين للتحوّل من ردّة فعل بُغية النجاة إلى تحوّلٍ مُستدام. فهي تدعم تعافي الأفراد كما الجماعات وتضع سلامتهم/ـن كأولوية. التدخلات المُتّبعة في حالات الصدمة قد لا تنتج حلولًا خلّاقة، فضلًا عن الصعوبات التي قد تمنع "التحقّق الكامل ... للاحتمالات" (جنرايشن فايف، 2007: 25). وبالتالي يُمَكّن التعافي والتغيير السلوكي المجموعات من الوصول إلى تدخّلات استراتيجية متماسكة "لتحويل الأوضاع التي تؤدي إلى وقوع العنف والعسف، وخلق عالم نسعى إليه ونستحقّه" (جِنِرايشن فايف، 2007: 25). يتطلّب ذلك تواضعًا وانفتاحًا على الإبداع والمواءمة والاستعداد لقبول الفشل ومعاودة المحاولة لمعالجة جذور العنف، كما يتطلب مواردَ مادية وزمنية لضمان استمرارية العمل. فمعاودة التجربة والخطأ هي عادةً عملية تتّسم بالحيرة والارتباك.
ملخّص عن الحالة الدراسيّة
في 31 تشرين أول/أكتوبر 2017 تلقّت مجموعةٌ من النسويات المصريات رسالةً إلكترونية من سيّدة تروي فيها تفاصيل واقعتين للعنف الجنسي تعرّضت لهما خلال عملها لدى "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية". في الواقعة الأولى قام أحد المحامين العاملين بالمركز، وهو محامٍ حقوقي ذائع الصيت، باغتصابها في العام 2014 تحت تأثير ثمالتها وغيابها عن الوعي. في الواقعة الثانية حاول مُرشّح رئاسي سابق مبادرتها بفعلٍ جنسي، كان بحسب وصفها أحد أكثر التجارب تقزّزًا في حياتها. دفع ذلك بالمرشح الرئاسي والمحامي الحقوقي6 المذكورين إلى الاستقالة من حزب "العيش والحرية" (سمير، 2018، مدى مصر، 2018). في كانون أول/ ديسمبر 2017، اتّفقت الحملة الانتخابية للمرشح المذكور مع الحزب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة. وقرّرت اللجنة المُشكّلة عدم الحديث مع أيّ من الأطراف والإبقاء على مجريات التحقيق طيّ الكتمان تجنبًا للضغوط الخارجية. بالإضافة لذلك لم يَطرَح الحزب أو الحملة الانتخابية على الحلفاء7 من المجتمع النسوي مسألة دعم المرشح من عدمه أثناء "الادعاء"8 عليه بالتحرش.
عندما أبصرت القضية النور، بَدَت معالم التحالف النسوي تتّضح في بيانين منفصلين صدَرَا عن مجموعتين نسويتين في شباط/فبراير 2018. صدر البيان الأول عن "ثورة البنات" وطالب بالإيقاف الفوري للمرشح الرئاسي المذكور، وتحديد موعدٍ لإعلان نتيجة التحقيقات، واستصدار بيان من قيادة الحزب يُوضّح فيه موقفه من القضية (انظر/ـي "ثورة البنات"، 2018). لم يلق أيٌ من تلك المطالبات جوابًا رسميًّا. فاوضت نسويات عدّة داخل هذه المجموعات للضغط على الحزب والحملة لفتح تحقيقٍ بالواقعة، وكانت اللجنة التي تمّ تشكيلها لاحقًا هي كلّ ما حصلوا/ـن عليه. بالمقابل، بقي الحزب والحملة على صمتهما، ولم تُتّخَذ أيّ خطواتٍ أبعد من ذلك.9 أتى البيانُ الثاني بصيغة عريضةٍ تحمل توقيعات عددٍ من المبادرات النسوية الشابّة، واللاتي كنّ بين داعمات الحملة الانتخابية خلال فترة الإعداد. حثّت العريضة الحزب على مشاركة التقرير الختامي للجنة التحقيق، وطالبت بتطوير أدواتٍ لمكافحة العنف الجنسي في الفضاء العام. من الجدير بالذكر أن الجيلَ الأصغر من النسويات كان ميّالًا للتشكّك في العمل المنهجي للتحقيقات التي تُحاكي منطق الدولة. استندت شكوكهن إلى عديدٍ من الحالات التي فشل فيها مثل هذا النوع من التحقيقات في إنزال "العقوبة" الملائمة على "الجُناة". ساءل هؤلاء النسوة كفاءة نُظُم ومنهجيات العدالة التقليدية في توفير مساحة آمنة للنساء.
في ظل هذا التخبّط، ظهر تيّاران استقطابيان: دافعت مجموعةٌ من النسويات عن المشروع السياسي للمرشح المذكور، بينما رغبت أخريات في إنهائه تمامًا. وبسبب الظرف السياسي، صبّ الجميع اهتمامه على قضية المرشح الرئاسي على حساب واقعة الاغتصاب. إلّا أن ما جعل الموقف أكثر تعقيدًا وإرباكًا كان رغبة الضحية / الناجية الامتناع عن المشاركة في سير التحقيق، إذ أشارت في آخر رسالة لها إلى أنها تريد أن تبقي على سلامها النفسي والذهني. برزت دوافع هذا القرار في تأويلات أطرافٍ أخرى ليس من بينها صاحبة الشأن: فأحال البعض ذلك إلى أن لجنة التحقيق ليست عازمةً بما يكفي على مواجهة العنف الجنسي، ما أثار المزيد من الجدل بين المجموعات النسوية وألقى بظلاله على موثوقيّة لجنة التحقيق ذاتها. أحال البعض الآخر ذلك إلى رغبة الضحية / الناجية "في الحفاظ على صحّتها النفسية" بتجنّب الانخراط في التحقيق.10 10. يستند ذلك إلى ترجمتي للبيان الختامي للجنة التحقيق والعريضة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ذكرت العريضة أن الضحية/الناجية وافقت على ما جاء فيها، إلّا أنه من الصعب التحقق من ذلك، فكاتب/ـة العريضة لم يـ/تزل غير معروف/ـة. بكل الأحوال، لم يمنع ذلك العديد من النسويات من توقيع العريضة.
في شباط/فبراير 2018 أعلنت اللجنة في تقريرها أنه تَعذّر إثبات "تهمة" التحرش الموجّهة للمرشح الرئاسي بسبب طبيعة صداقته مع "المدعية" والتي يعلم بها المجتمع المحيط بهما. لم تستطع اللجنة "إثبات" الادعاء بسبب "امتناع المدّعية عن الإدلاء بشهادتها حول درجة ثمالتها ليلة الواقعة".11 بالتزامن مع ذلك، ذكر التقرير أن المحامي الحقوقي ارتكب "فعلًا مشينًا"، وطالبه بالاعتذار عن عدم الاعتناء بزميلته عندما بدت مُتعبةً وغائبةً عن الوعي. التقرير الختامي، في رأيي، هو وثيقةٌ غير متّسقة. فمن ناحية، عمدت اللجنة إلى استخدام لغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المدني المصري، في إشارتها إلى حقوق "الادعاء والدفاع والشهود"، مؤكّدةً القاعدة القانونية القائلة "ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته". ومن ناحية أخرى، عبّرت اللجنة عن استعدادها لمساعدة الضحية / الناجية لإثبات القضية، إذ عرّف التقرير العنف الجنسي كظاهرةٍ ثقافية، بما يُرسّخ النسق الجاري للعنف الجنسي. لذا يُمكن النظر للتقرير كمحاولة لتعريف وتأطير العنف الجنسي. إلا أن فاعلية تلك المحاولة جاءت مغلولةً بإحالتها للأطر القانونية. أخفقت اللجنة والمجتمع في التحرّر من قيد فكرة القانون وفي إعادة النظر في واقعيهما.
وبينما أشتبك مع القضية، لا أسعى إلى حلّها أو توجيه أصابع الاتهام. وأربأ عن إخبار القصة بالإنابة. بدلًا من ذلك، أنظر إلى المقاربة التي اعتمدتها المجموعات النسوية والأفراد للوصول إلى الحلّ. من المهم أيضًا توضيح أن للنسويات في مصر هويةٌ مزدوجة، فكثير منهن يعملن لدى مؤسسات غير حكومية وهنّ ناشطاتٌ نسويات في الوقت ذاته. شهدت القضيةُ محلّ البحث تدخلًا من منظّمتين غير حكوميتين، الأولى هي مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" وشمل تدخّلها إطلاق حملةٍ أُطلق عليها "الموجة الرابعة" رَكّزت على العنف الجنسي في الفضاء العام وتأثيره على القيادات النسوية الشابّة. وأتى التدخل الثاني من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والتي زوّدت لجنة التحقيق بدراسةٍ إطارية عن العنف الجنسي في أماكن العمل. استُدعِي أعضاء اللجنة للإشراف على التحقيق استنادًا إلى هويتهم/ـن الشخصية كنسويات أو لمراكزهم/ـن المهنية كمحامين/ـات بارزين/ات في مجال العنف الجنسي. وينبّه هذا التموضعُ السياسي لهؤلاء الفاعلين/ـات إلى أثر "أنجَزَة"12 الحركة النسوية المصرية على السعي لاعتماد إطار العدالة الانتقالية، وهو توتر سأعود إليه لاحقًا.
إعادة قراءة قضية خالد علي ومحمود بلال وفتاة الإيميل من منظور العدالة الانتقالية
عُرِفَت القضية إعلاميًّا باسم "فتاة الإيميل" إلّا أنني قررتُ عمدًا استعمال اسمي خالد علي ومحمود بلال للإشارة لها. فمع الوقت، توارى الأشخاص المفترض بهم الخضوع للمساءلة وبقيت وحدها "فتاة الإيميل". يعكس هذا، في تصوّري، كيف تهجس حوادث العنف الجنسي الضحية/الناجي/ـة وتختزله/ـها في أن يُـ/تُعرف بدلالتها. في الوقت ذاته، يُخلي الرجال ساحتهم وتنجلي أسماؤهم مع الوقت مستفيدةً من المحو الاجتماعي للذاكرة.
أ- المقاربات والمنهجيات: ما المصادر التي يمكن الرجوع إليها؟ ومن يشترك في التخطيط ووضع الرؤى؟
من الحري الإشارة إلى أن اللجنة لم تنطلق من مفهوم العدالة الانتقالية، بل من محاكاة لمفهوم دولتيّ عن العدالة. لذا يحاول هذا التحليل توضيح كيف يمكن أن تكون العدالة الانتقالية ذات نفع فيما يستجد من قضايا، وليس قياس مدى التزام التحقيق بمفهوم العدالة الانتقالية. اعتمدت اللجنة على التعريفات القانونية لمفاهيم التراضي والعدالة والأعراف القانونية المُتّبعة في بناء الاتهام.13 واعتبر التقرير الختامي أن غياب الضحية / الناجية عن التحقيق قد أثّر بالسلب على سير التحقيق، إذ لم تتمكن اللجنة من التحقّق ممّا إذا كانت الضحية / الناجية ثملةً أو قادرةً على إبداء الموافقة على فعل جنسي رضائي. ورغم إخبار الضحية لقصّتها عبر رسالة بريد إلكتروني، لم تنظر اللجنة لتلك الرسالة بوصفها شهادة لأنها لم تقع ضمن ترتيب يحاكي مجريات التقاضي الرسمي في قاعة المحكمة: لم تتقدم الضحية / الناجية إلى اللجنة ولم تقم بإعادة سرد شهادتها بشكل "رسمي". وبالتالي، لجأت اللجنة لاستشارة طبيب مختصّ حول تأثير الكحول على قدرة الضحية / الناجية على إبداء الموافقة. فبرغم أن قرار اللجنة لم يأت مدعومًا "بحشد الافتراضات والتوقّعات المحتملة لكيفية سير العلاقات الجنسية الاجتماعية "العاديّة" في عصرنا الحالي" (إليسون ومونرو، 2009: 307) – على النقيض كانت اللجنة منفتحةً على تجاوز مثل هذه التوقّعات14 – لم تستطع اللجنة التحرّر من أسر تصوّرها عن سير المحاكمات التقليدية. بالمقابل من هذا، تلتفت العدالة الانتقالية إلى السلامة النفسية كأولوية خلال عملها. يعني ذلك أن حماية الضحية / الناجية من تذكّر واختبار الصدمة مُجدّدًا يجب أن يكون البوصلة التي تهتدي بها أي عمليةٍ للمساءلة. وفي هذه الحالة يُمكِن لرسالة البريد الإلكتروني أن تكون شهادة، أو كما حدث في حالةٍ سابقة في مجموعة كريساليس، يمكن لمجموعة من النساء و/أو الرجال ممّن يحظون/ـين بثقة الضحية/الناجية أن يلعبن/ـوا دور الوسيط بينها وبين اللجنة. على المقلب الآخر، لم تتضمّن عملية وضع الرؤى أي تعصيفٍ ذهني جماعي أو استعانة برأي أيّ من المجموعات النسوية. لم يكن ثمّة توضيح أو تواصل داخل الحزب أو الحملة الانتخابية أو حتى داخل الدوائر النسوية على اتساعها. أشاع هذا التعتيم مناخًا انقساميًّا دفع المجموعات النسوية للإسراع بإصدار بياناتٍ سياسية عوضًا عن العمل التشاركي.
أزعم أن اللجوء إلى الأدوات القانونية "لإثبات الجرم" ليس فعّالّا عند يتعلّق الأمر بالعنف الجنسي، إذ تفشل تلك الأدوات عادةً في تشخيص العنف الجنسي كظاهرة وبائية لا كفعل فردي عارض. كما تستحوذ معضلة "الدليل" على التحقيق في قضايا الاغتصاب، ما يدفعنا للتساؤل أيّ دليلٍ يمكنه أن يكون دليلًا كافيًا؟15 فحوادث العنف الجنسي عادةً ما تحدث داخل فضاءاتٍ خاصة ومُغلقة تجعل من "الإثبات" محض هرطقة وعثرة لا يمكن تجاوزها إلا بوعي لجنة التحقيق (أليسون ومونرو، 2009: 292). وعليه، فالاعتماد على الأشكال التقليدية للأدلة القانونية يُفسِح المجال لثقافة إلقاء اللائمة على الضحية وإثقال كاهلها بعبء جمع القرائن. في الحالة الدراسية التي أتناولها هنا، أدرَكَت اللجنة كل هذه المكوّنات الاجتماعية، إلا أنها ومع ذلك، عجزت عن الوفاء بمقتضيات إدراكها هذا، وصُفّدت يدها بمجريات المحاكمة الرسمية كسبيل أوحد لإثبات العنف الجنسي. غابَت عن لحظِها طبقاتٌ من العنف الدولتيّ تقبعُ طيّ أوراق القضية: فالناجية لن تتمكّن أبدًا من إبلاغ الشرطة تجنبًا لذكر تفاصيل الثمالة والاختلاء بزميلها في منزله لساعةٍ متأخرةٍ من الليل. والبُنية الغيريّة المعياريّة لمؤسسة الشرطة لن تُلحِق بالناجية إلا مزيدًا من الأذى.
من منظور العدالة الانتقالية، لا يُمكن للنظام القانوني (المحكمة والسجن والقوانين، إلخ.) أن يُعالجَ الضررَ الناتج عن العنف الجنسي كما ينبغي (كيلي، 2010: 50). وتُقدّم العدالة الانتقالية نموذجًا للتخطيط والتحليل يتجاوزُ المحدّدات التعريفية والمرجعية القانونية. ويُشجّع المجتمعات على النظر إلى ما هو أبعد من السبب المباشر للأذى إلى تقصّي النظم المتقاطعة داخل المجتمع. عوضًا عن سؤال أي القوانين قام "المتهم" بخرقها، تتساءلُ العدالة الانتقالية عن البُنى الاجتماعية وأشكال العسف التي تُمَكّن لهذه الأشكال من العنف. في السياق المصري، تَنظرُ العدالة الانتقالية إلى العنف الدولتيّ وغياب أنظمة الإبلاغ والتقرير والسياق السياسي للواقعة وعلاقة المجموعات اليسارية بالدولة وموقع قضايا المرأة على خريطة المعترك السياسي. كل هذه الأمور تقعُ ضمن منظور المساءلة الجمعية التي تطرح رؤيةً عامةً لتقصّي جذور الوقائع المتكرّرة للعنف الجنسي. وفيما يخصُ التخطيط الجمعي مع الضحية / الناجية ومع المجتمع، تؤسسُ العدالة الانتقالية لشعورٍ عام بالثقة في مجريات التحقيق، فمن يقرر سيرَ التحقيق ليسوا مجموعةً من الفاعلين الخارجيّين وإنما هو اتفاقٌ ينبني على الخبرات المختلفة والتعريفات المتنوّعة للعنف الجنسي.
الحالة الدراسية التي نحن بصددها يُمكنها أن تدلّل على المحددات التي تقف بوجه هكذا إطار. فالعدالة الانتقالية هي عمليةٌ متسقةٌ من التجربة والخطأ، لذا يلزمها الوقت والموارد وغيرها ممّا قد لا يتوافر لمجتمعات النشطاء/الناشطات. بالإضافة لذلك، يَلزَم أولًا استعداد المجتمع لتقبّل العدالة الانتقالية، فالسعي للعدالة خارج إطار النظم العقابية المقيّدة للحرية وفي الوقت عينه تعهّدُ الجراح المجتمعية الدامية بالرعاية وتنفيس الغضب المكتوم والسماع للقصص غير المروية ليس أمرًا هيّنًا بالنسبة لنساءٍ ومجتمعاتٍ ترزحُ تحت سنين من العنف. كما أن الالتزام بإنهاء الأسباب الجذرية للعنف الجنسي ليس دائمًا مضمونًا، فتغيير الأفكار والسلوكيات قد لا يكون دائمًا صادقًا. ويحثّ ذلك الأطراف المعنية على الوثوق ببعضها البعض والوثوق بسير العملية واستمرار النقد والإبداع، رغم صعوبة ذلك، ورغم ما ينتج عنه من خروقٍ تُفتح دون حسم. على سبيل المثال، كما هو الحال مع القضية قيد الدرس، يمكن أن ترفضَ الضحية/الناجية أو الأطراف التي تسبّبت في الأذى – أفرادًا وأجسادًا – الاشتراك في العملية. فضلًا عن ذلك، فالثقة بين الأطراف تلك قد يعوّقها تاريخٌ من الوقائع الجنسية غير المحسومة، ما يخلق مزيدًا من الخصومات السقيمة. تُظهِر القضية قيد الدرس أيضًا التوتّر بين المجموعات النسوية حول أفضل الطرق لمعالجة القضية ومنهجية تناولها من قبل حزب "العيش والحرية" أو من قبل لجنة التحقيق، كما تُظهِر التوتّر حول الأسباب التي دفعت بنشر النتائج النهائية للتحقيق. ففي حين يُعطى مزيدٌ من الوقت لقضايا العنف الجنسي، استغرق إصدار التقرير النهائي أربعة أشهر، وهو إطارٌ زمني وجدته مجموعات نسوية عدّة مقلقًا، بالنظر لكون رسالة البريد الإلكتروني "دليلًا" يُعتَد به في حالات الاغتصاب والتحرش. جاءت تلك التوتّرات كنتيجةٍ لتراكم الإحباطات من قضايا سابقة لم تحصلُ النساء فيها على الدعم المناسب، أو من قضايا لم تَتمكّن النساء فيها من إثبات "جُرم" الرجال. تَتفهّم العدالة الانتقالية الصدمة والإحباط والتوتّر المتراكم والفشل. كان ليكون مشجّعاً لنا الاعتراف بقصورنا والحشد انطلاقًا مما يمتلكه كل منّا من قوى. كانت العدالة الانتقالية ستُوّفر الوقت اللازم للتعافي الجمعي وتصفية تَرِكة سنوات من الظلم.
ب- على من يقع الأذى؟
تضع العدالة الانتقالية الأولوية لدعم الناجي/ـة. فضلًا عن الجانب النفسي، قد يأتي الدعم كاحترامٍ لرغبة الناجي/ـة في اختيار السبيل والمدى الأمثل للانخراط في العملية. تضع هذه المقاربة الناجي/ـة في المركز من كل شيء لتَبنّي عملية للمساءلة التشاركية تُمكّن أوسعَ تنوّع من أشكال التعافي. ربما في الحالة قيد الدرس، لم يكن الدعم النفسي هو الجواب المناسب، إذ أن الناجية لم تطلبه، كما أنها تلقّت بالفعل علاجًا نفسيًّا متخصصًا. غياب الدعم المباشر بالمقابل أدّى إلى افتراض غياب كل أشكال الدعم، أو افتراض أن السبيل الوحيد للدعم هو إثبات "جُرميّة" الفعل ومعاقبة الفاعل. إلا أن الدعم كان من الممكن أن يشمل أيضًا التواصل بشأن سير التحقيق، إذ أشارت في رسالتها الإلكترونية إلى انعدام ثقتها فيما قد يتمخّض عن أي رد فعل مجتمعي.16 كان من الممكن أن يأتي الدعم في صيغة تقديم استشارة وتكوين تحالف أو تفهّم لنفورها من مجريات تُحاكي عمل المحاكم التقليدية.
ولمّا كان العنف الجنسي واقعةً متكررةً في الدوائر اليسارية والحقوقية في مصر، تُعاني النسويات صدمة غياب الشعور بالأمان في تلك الدوائر أيضًا. هذه الحالة من الصدمة الجماعية لم يسبق أن تمّ التطرق إليها، خصوصًا وأن الضحايا / الناجيات هنّ عادة الهدف الأسهل لتسليط الأضواء. أنتج التعامل مع الصدمة والغضب والإحباط مناخًا استقطابيًا تبدو فيه التدخلات المطلقة والجذرية كسبيلٍ وحيدٍ سريع نحو العدالة. لم يكن من السهل على المجتمع النسوي واليساري تَفَهّم أن المسألة لا تتعلّق بالواقعة وحسب، بل بكلّ ما سبقها ويليها من وقائع. تراكم الغضب والأسى والصدمة كان جزءًا من الوعي الجمعي وبدا كما لو أن المجموعات النسوية تتحرك وتعمل بمنطق غريزة البقاء. كان من الصعب التريّث والتأمّل والفهم. الدعم في هذه الحالة كان يعني "الإنصات إلى كل تلك الفوضى دون إصدار أحكام، ودون إرغام على السير بحلول فورية" (روسو، 2019: 119). عبر هذا التعريف الموسّع لمفهوم الضحية/الناجي/ـة يحصل المجتمع على فرصة لعدالة التعافي التي "تُقرّ وتستوعب طبقات فوق طبقات من الصدمة والعنف مرّ بها [المجتمع] وعانى منها على مدى أجيال. كما أنها تستدعي ممارسات جمعية للتعافي والتحوّل. تدرك هذه العدالة أن [للمجتمع] أجسامًا وعقولًا ومشاعر وأفئدة وأنه لا يُمكِن إنجاز التحوّل المجتمعي دون تفعيل للتعافي الجماعي" (جاغرنوت، ورد في كابا، 2010).
ج- من المتسبب بالأذى؟
رغم توصية اللجنة باتخاذ المزيد من الخطوات،17 فإنها لم تَتَمكّن من تحديد كلّ الأطراف المعنيّة بوقائع العنف الجنسي المتكرّرة في دوائر المجتمع المدني. لم يشترك "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في سير التحقيق، رغم كون المتّهمَين جزءًا من فريقه في حينه أو سابقًا. ولا تقع مسؤولية محاسبة المركز على اللجنة، فالقضاء على العنف الجنسي يتطلّب تدخّلًا جمعيًا. لم تُسائل المجموعات النسوية غياب المركز عن المشهد، كما لم تُتّخذ أي خطوات حيالَ ذلك أثناء أو بعد التحقيق.
تحثّ ثنائية الضحية / الجاني المجتمعات لأخذ ردّ فعل ضد فرد بعينه، دون ترك فسحةٍ لفهم طبقات التمييز والأبوية التي جعلت الفعل العنفي ممكنًا. الأشخاص المتسبّبون بالأذى ليسوا شياطينًا ولا هم أشرارٌ بالخلقة. ترمي العدالة الانتقالية إلى النظر إلى ما هو أبعد من سبب الأذى والابتعاد عن شخصنة الفعل العنفي المبني على طبقات متقاطعة من العسف (روسو، 209: 86-98، كيلي، 2010: 48-49). بالإضافة لذلك، تطرح العدالة الانتقالية نموذجًا للتكامل والمساءلة عندما يتعلّق الأمر بسبب الأذى. فعوضًا عن معاقبة الأفراد أو نبذهم اجتماعيًا، تدفع العدالة الانتقالية لخلق مجال لدعم الأفراد والمجموعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية كي تتسنّى إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. وبهذا تُشجّع الأفراد على أخذ زمام المسؤولية عن أفعالهم/ـن وفهم جذورها الأبوية والتمييزية. ومن وجهة المؤسسات والمجتمعات، تُساعد العدالة الانتقالية على إبراز الممارسات التي تحضّ على العنف الجنسي، وبالتالي تقضي على أسبابها الجذرية. وبالنسبة لهؤلاء الذين تسبّبوا في الأذى تفتح العدالة الانتقالية المجال لهم لتأمل أفعالهم وشعورهم إزاءها وتُقدّم لهم الدعم اللازم لإعادة دمجهم في المجتمع. في القضية قيد الدرس، تَضمَن الممارسات المؤسسية تدخّلات مبكرة (كالمناقشات والسياسات وجلسات التوعية وغيرها) تتطرّق للعنف الجنسي قبل حدوثه، فالعدالة الانتقالية تعمل على الماضي والحاضر والمستقبل. بعبارةٍ أخرى، تُشجّع العدالة الانتقالية الحوار عمّا يُمكِن أن يُتّخذَ من إجراءاتٍ لمنع العنف، ولا تقتصر على التدخّل بعد حدوثه.
د- التدخل النسوي الجمعي: "نحن" وليس "أنا"
العدالة الانتقالية هي قرارٌ جمعي يُتّخذُ بالجهود الجمعية، وتعتمد على بناء التحالفات والتخطيط الجماعي بالنظر إلى تموضع كل مجموعة ضمن الحراك. هذا المجتمع ليس طوباويًا، بل هو مجتمعٌ يؤمن بأهمية توفير بيئة للتعلّم والازدهار للجميع. لذا يجب أن تنتبه كل مجموعةٍ نسوية في هذا النموذج لما لديها من امتيازاتٍ ومحدّدات بحكم تموضعها وعليها أن تتعاون مع المجموعات الأخرى نحو هدفٍ مشترك. وبرغم توظيف كلّ مجموعةٍ لأدواتٍ مختلفة، إلا أن هذه المجموعات يجب أن تحفَظَ تناسق واتساق الجهد الرامي إلى الهدف المذكور. كما أنها يجب أن تَتَفهّم تبعات العمل تحت تأثير الصدمة في سعيها للتعافي الجمعي وبناء مرونة تَضمَن مواصلة المقاومة.
تطبيق مبادئ التخطيط الجمعي وبناء التحالفات والتعافي الجمعي على القضية قيد الدرس، يُظهِر أن المجموعات النسوية في مصر قد أضاعت فرصةً لبناء خطةٍ طويلة الأجل لوضع آليات يُمكنُها مقاربة العنف الجنسي في دوائر المجتمع المدني. كان غيابُ الجهود الجمعية الاستراتيجية سببًا في تكريس ثنائية بين اللجنة والحزب ومجريات التحقيق في واقعتي الاغتصاب والتحرش من جهة، وبين من هم/ـن في انتظار نتائج القرار النهائي للجنة من جهة أخرى. مقاربة القضية من منظور العدالة الانتقالية كانت تقتضي التدخّل الجمعي منذ اليوم الذي وردت فيه الرسالة الإلكترونية وعند تشكيل لجنة التحقيق. كان التدخل النسوي الجمعي لينتهز الفرصة لتناول قضية العنف الجنسي داخل دوائر المجتمع المدني، من خلال تطبيق توصيّات لجنة التحقيق وتنسيق برامج التوعية داخل المؤسسات غير الحكومية ودوائر المجتمع المدني. بالمقابل، بدت العملية كما لو أنها انتهت بصدور التقرير، تاركةً وراءها عبء الصدمة والإحباط. يتطلّب الأمر المزيدَ من الوقت لفهم وتحليل تبعات التقرير على مسألة الثقة والتبليغ عن حوادث العنف الجنسي في المستقبل وقدرة النساء على الانخراط في دوائر المجتمع المدني، بالنظر إلى العقبات التي تَحوُل دون التبليغ ومعالجة هذه الحوادث عبر حلول مجتمعية وفي ظل التهديد المستمر للعنف الجنسي.
تعاني العلاقة التكاملية بين النسويات الشابّات والأجيال الأكبر من فجوة في البحث والتأمل تُضيء على المواقع المتنوعة داخل الحراك النسوي في مصر. ويُعدّ هذا الفهم أساسيًا في بناء التحالفات، فهو يضمن النقد الذاتي كسبيل للوصول إلى حلول وسط، وهو ما يختلف عن إلقاء اللوم أو توجيه أصابع الاتهام. يُشبه الأمر عملية عصف ذهني عمّا حدث، وكيف تفاعلت معه الأطراف المعنيّة، وكيف يمكن للأمور أن تتحسّن في المستقبل، بدلًا من تقسيم المعسكرات. من المهم أيضًا مراعاة ما استجدّ من عناصر للتنظيم. إذ تُوفّر التقنيات الرقمية مساحةً افتراضية للتنظيم بمعزل عن تلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، حيث تعتمد في الغالب على الأساليب المنهجية والسياسات التنفيذية الواضحة. إن فهم الاختلافات بين الآليات التي تستخدمها كل مجموعة أمرٌ لا بد منه في رسم حدودنا ونقاط قوتنا الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يُسهّل الحوار وبناء جسور الثقة. هدفي هنا ليس انتقاد شكلٍ من التنظيم لصالح آخر ولا الدعوة إلى شكلٍ موحّد من التنظيم. بل أود الإشارة إلى الاختلافات بين الأشكال المتنوّعة للتنظيم. التنظيم الرقمي هو مساحةٌ مفتوحةٌ للضغط غير المُنظّم. بتدقيق النظر إلى القضية، يمكننا أن نرى بوضوح كيف يتجلّى عنصر التنظيم الرقمي: المشاركات والتغريدات الغاضبة والأسئلة والمخاوف وحتى السخرية والرسوم الهزلية والميمات. فقد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي مساحةً للنسويات الشابّات على وجه الخصوص للتحدّث دون الحاجة إلى حضور الاجتماعات الرسمية أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني. فمن الجدير بالنظر أن البيانَين الصادرَين عن المبادرات النسوية المستقلّة كانا قد نُشِرَا عبر فيسبوك، كما أن حملة #الموجة_الرابعة كانت بالأساس حملةً رقمية.
لقد فكّرت طويلاً في كيفية التعامل مع الحراك النسوي آخذةً في الاعتبار العلاقات العابرة للأجيال ومفاعيل "أنجَزَة" الحراك وظهور المجموعات النسوية المستقلّة والتحوّل الرقمي والهجمة الأمنية الضارية على المجتمع المدني المصري والتي أضافت قيودًا جديدة على الوصول إلى العدالة، ضمن أمور أخرى. كلّ عنصرٍ لديه القدرة على إثارة التوترات داخل الحراك النسوي مع كل حالةٍ جديدةٍ من حالات العنف الجنسي. لكنني أدركت أنه يمكننا أن نبدأ من فهم الغضب والإحباط غير المعلنين. ربما لا تَكمُن أهمية القضية في منهجيات معالجة العنف الجنسي في مصر فحسب، بل أيضًا في التوتّرات المتراكمة داخل الحراك بالترافُق مع الجراح التي لم تلتئم جرّاء العنف الجنسي، والتي تُؤثّر على كل امرأة في دوائر المجتمع المدني في مصر. أدركت أنه يمكننا أن نبدأ بالاعتراف بالتوتر والقبول بالغضب وتشجيع التأمل الجماعي حتى نَتَمكّن من البحث عن التعافي والعدالة بدلًا من تعليق المشانق. بالإضافة إلى ذلك، تُؤثّر هذه التوتّرات على تبنّي العدالة الانتقالية – وهي عمليةٌ تَتَطلّب، كما ذَكَرتُ سابقًا، الصبر والثقة والانفتاح والمحاكمة وتكرار التجربة والخطأ من أجل تكييف أدواتنا ومنهجياتنا المحليّة للتعامل مع العنف الجنسي.
لا يُمكِن إنكار أن المجموعات النسوية المصرية حقّقت العديدَ من الانتصارات في مجال مكافحة العنف الجنسي منذ ثورة 2011. "تُعتبر هذه الانتصارات مهمّة، ولكن، كما في حالة حزب "العيش والحرية"، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه" (عبيد، 2018). لا يمكنني استخلاص استنتاجات بشأن التوتّرات بين الحركة النسوية المصرية في هذه الورقة وحدها، وبدون مساهمات من نسويات أخريات. لكنني أصرّ على توثيق الحادث بكل فوضاه من أجل إظهار تكرار هذه التوترات، التي ستظل تتراكم ما لم نتوقّف لبرهة ونتحدّث.
خاتمة
حاول تحليلي تسليط الضوء على كيف يمكن لاعتماد نهج العدالة الانتقالية في معالجة العنف الجنسي أن يؤدّي إلى آلياتٍ أكثر شمولية. تُقدّم العدالة الانتقالية منظورًا لما وراء انتساب العنف الجنسي للأفراد كضحايا أو جناة. تُوفّر العدالة الانتقالية مساحةً يكون فيها الخيال والإبداع حرًا بدلًا من الاستمرار بذات النهج الذي أثبت عدم كفايته مرارًا. لقد رسمت صورة تخيلية لكيف يمكن لقضية نسوية مصرية أن تبدو حال تناولها من منظور العدالة الانتقالية.
أثناء عملية الكتابة، أدركت أنني أكتب تحت الضغط والاستقطاب والميل إلى طرح "دليل" أو "كتيب إرشادي" آخر حول كيفية إنهاء العنف الجنسي. لقد زلّلت في نفس الاندفاع للعثور على إجابات دون قضاء الوقت في تفهّم الصدمة والتوتّر. اعترفت لنفسي بخوفي الداخلي من أن يتمّ تصنيفي في معسكر ضد الآخر أو اتهامي بالتقليل من الجهود المبذولة خلال القضية. تخوّفت من الفجوة الهائلة في الشهادات التي تناولت التوترات النسوية في مصر والتي أثارتها أحداث العنف الجنسي. تأرجحت بين محاولتي لتحرير نفسي من القيود التقليدية المتأصّلة في نفسي، ورغبتي في تفهّم وتسمية هذه التوترات. أزعم أن هذا التأرجح هو الخطوة الأولى نحو العدالة الانتقالية. فقبول أن الإجابة هي أنه لا توجد إجابات جاهزة، هو ما يدفعنا لتفكيك ذهنياتنا وافتراضاتنا.
في النهاية، استسلمت لحقيقة تردادي للقيود التي قد تنشأ عند تبنّي إطار العدالة الانتقالية: كالرغبة في التمسّك بالنظام حتى لا نفقد السيطرة، والخوف من الزلل. بينما أدافع عن العدالة الانتقالية، فأنا لا أحاول التقليل من شأن الجهود النسوية في مصر أو إلقاء اللوم عليها. بالعكس، أنا أدافع عن الإشادة بالممارسات السابقة من خلال الانكباب على فهم وتحليل ما حدث.
فمن ممارسة أعضاء اللجنة يمكننا أننا نرى إمكانيات التغيير والتحوّل لمستقبل مختلف نبنيه سويًا. نتعلّم من خلال الممارسة، ونحتاج إلى الاستعداد لمواجهة وتقبّل أخطائنا وإخفاقاتنا وزلاتنا وكذلك نجاحاتنا وتحولاتنا. الممارسة هي الطريق نحو احتمالات جذرية لا حصر لها، ولكن فقط إذا تقبلنا العملية بتواضع وانفتاح وفضول وأمل (روسو، 2019: 109).
إن العدالة الانتقالية ليست طوباوية ولا تقدّم إجابات جاهزة. إنها إطار يسمح للمجتمعات بتطوير أدواتها الخاصة لإنهاء الأسباب الجذرية للعنف الجنسي دون معالجة أحداث العنف الجنسي على أنها "صرعة" سرعان ما تفقد وهجها. تَتَطلّب العدالة الانتقالية التواضع والاتساق لقبول الفشل والقدرة على المضيّ قدمًا.
ختامًا، شعرت بالحاجة إلى توثيق ما مررت به أثناء كتابة هذه الورقة، ولو كان وجيزًا – من آلام جسدية، ولمحات خاطفة من الماضي والغثيان والكوابيس والمهدّئات والعديد من نوبات الهلع. بدأت بمحاولة أن أكون موضوعيةً قدر استطاعتي لتجنّب خلق المزيد من التوتّر النسوي أثناء النظر في المشاركة النسوية المصرية في القضية قيد الدرس. شعرت بالضغوط وضرورة كتابة ما يبدو "صحيحًا" والحاجة إلى تجنّب تضمين مشاعري وعاطفتي، حتى لو كانت تلك هي صنو الكتابة النسوية. ابتلعت الحاجة المُلحّة لأصرخ بصوت عالٍ، "لقد سئمت"، كما الحاجة إلى إعلان فقدان الثقة في أي أمر من شأنه أن يحقّق العدالة والتعافي والمساءلة في واقعنا المخيف. كيف لهذا ألا يستفزّني؟ كانت هذه القضية على وجه الخصوص رمزًا لكل حالة عنف جنسي مرّت بها أيٌ منّا، وفي كلّ مرّة خذلتنا العدالة الرسمية وغير الرسمية – إنها لحظةٌ مثقلةٌ بالألم الجماعي الذي يعتمل في كل ما يسمى بـ "فضاءات آمنة بديلة". كان المضي قدمًا في القضية والدعوة إلى إعادة التأهيل والتعافي لأولئك الذين تسبّبوا في الصدمة، تجربة تعليمية، وإن لم تكن سهلة. كان التنفّس أثناء الكتابة مهمّةً صعبة، ناهيك عن وضع الاستراتيجيات. تعلّمت أن محاولة تفكيك سنوات من العنف الجنسي المُعقّد والتوتّرات النسوية التي يخلقها لا يمكن أن تحدث أثناء وقوفنا فرادى، فالتنظيم المجتمعي أمرٌ لا بد منه. وهذا لن يحدث أبدًا ما لم نبدأ في التحدّث إلى بعضنا البعض، والتلفّظ بالكلمات الأولى، "فلنجلس ونتحدّث، ثمّة شيء لا يعمل هنا". أخيرًا، أنهيتُ هذه الورقة محاطةً برعاية وحبّ أربع صديقات رائعات وأعلم أنّ بناء مجتمع من العدالة والتعافي والمساءلة وإعادة التأهيل لا يتطلّب أقلّ من قريةٍ نسوية.